وكالة أنباء الحوزة ـ ألقى الأستاذ حسن رحيم بور أزغدي محاضرة تحت عنوان المدارس المعاصرة في ميزان حكومة أمير المؤمنين عليه السلام، وتطرق فيها إلى ما تضمنته الشريعة الإسلامية من حقوق وواجبات، وميزات حكومة الإمام عليه السلام، وفيما يلي نقدم لكم نص المحاضرة:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد (صلی الله عليه و آله).
الدين الإسلامي يضمن الحقوق والواجبات
إنَّ الإمام علي كانَ روحاً كبيرةً في جسم العالم الضيّق. ولم يكن المجتمع أهلاً لأن يكونَ الإمامُ بينهم، كانَ أكبر من ذلك المجتمع، وسِعَة تحملهِ كانت أكبر. وعندما نسمع اسمَ الإمام عليّ عليه السلام وتصرفهُ وأركانَ حكومته، نعي أنَّ الحديثَ ليسَ حولَ عظمة هذا الشخص الفردية، بل إنَّ الحديثَ يدورُ حولَ مدرسته، حيثُ كانَ الإمامُ أنموذجاً بارزاً في ذلكَ الوقت، وقد تربَّى هذا الإمام في مدرسة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. وكانَ بمثابة التلميذ البارز بين تلامذة هذه المدرسة، وتعلَّمَ من النبي أنَّ المجتمعَ الديني ينبغي أن يكونَ صريحاً في الدفاع عن حقوق الضعفاء والمحرومين ومُستضعفي المجتمع، الذينَ لا يستطيعونَ المطالبة بحقوقهم، لا بل الذين لا يعرفونَ حقوقهم الدينية ولا كيفَ يستوفونها من أصحاب القوَّة والثروة والسلطة. هذا هو تعريف المجتمع الديني الذي نَقَلَهُ الإمام عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، حيثُ نَقَلَ عنهُ القول: سمعتُ رسولَ الله يقولُ في غيرِ موطنٍ: (لن تُقدَّسَ أمةٌ لا يؤخذُ للضعيف فيها حقهُ من القوي غيرَ مُتَطَئْطِئْ)[1]. ويعني أنَّ المُستضعفينَ الذينَ لا يعرفونَ كيفَ يستوفونَ حقوقهم، فهناكَ من ينبغي بأن يقومَ بذلكَ من الحاكمية. هذا التعريف جاءَ على لسان الإمام عليّ حيثُ قالَ غيرَ ذي مرَّةٍ: (أنا عبدٌ من عبيدِ مُحمد)[2]. نعم، قالَ أنا عبدٌ من عبيد محمدٍ صلى الله عليه وآله، أي إنَّ كُلَّ ما عنده عن النبي صلى الله عليه وآله.
وفي قاموسِ علي بن أبي طالب تبدو الدولة الدينية هي ضامن العدالة وحقوق الرب، وقوانينه وحقوق أهله وحقوق الناس في ذيلِ حدود الدين. وعليه فإنَّ حقوق الناس أمرٌ مُقدَّسٌ في المجتمع الديني، لأنَّ حُرَم الناس من حُرَم الرَّب وحقُّ الناس. وطبقاً للروايات المنقولة عن الإمام عليّ عليه السلام هي جزءٌ من حقوق الله سبحانه وتعالى. وحقوق الناس بتعريفٍ ديني وليسَ ليبرالياً أو ماركسياً. إنَّ الاعتداء على حرمة الإنسان وحقوقه الأساسية يُعدُّ اعتداءً على حرمة الله عز وجل. هذا هو منطق الإمام علي عليه السلام.
وقد أشار إلى ذلك في نهج البلاغة تكراراً وبتعابيرَ مختلفة، ونُقِلَ عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: (من قُتِلَ دونَ حقِّهِ فهو شهيد)[3]. وهذا ينعكس على الحقوق المادية والمعنوية، أي العزَّة والكرامة الإنسانية، وكلُّ من يُقْتَل في سبيل الدفاع عن حقوقه التي حدَّدها الله سبحانه وتعالى فهو جهادٌ ضدَّ الظلم. هذا الأمرُ يُعَدُّ ردَّاً على كافة أولئك الذينَ كتبوا وقالوا إنَّ الدينَ تكليفٌ وحسب، وإنَّ الحقَّ والحقوقَ لم يُشَر إليها في الدين. كيفَ لم تَتِمَّ الإشارةُ إلى الدين بهذه الصورة؟ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشارَ بنفسهِ أنَّ من يُقْتَل في سبيل حقوقه، كمن يُقتل في سبيل الله شهيداً، كمن حاربَ في بدرٍ وأحُدٍ إلى جانب الرسول وقُتِلَ هناك.
إنَّ الدينَ الإسلامي دقيقُ للغاية، فيما يخصُّ حقوقَ الناس، ولكن ليسَ الحقوق المُجرَّدة دونما تكليف، بل الحقوق التي تكونُ ناجمة عن تقبّل المسؤولية، وفي الرؤية التوتاليتية والأنظمة الاستبدادية فإنَّ المواطنينَ عليهم أن يؤدوا الواجبات ولا حقوقَ لهم. وفي الأنظمة الماتريالية، الليبرالية، الرأسمالية، الإنسانية و الحقوق في الحقيقة على الورق وليسَ على التطبيق الواقعي. فإنَّ للناس حقوقاً ولا حديثَ عن المسؤولية، وعندما يتحدث الإنسانُ هناكَ عن الواجبات فإنهُ سيُتَّهمُ بنقض حقوق الإنسان، وعندما يتحدث عن التطلعات والحدود القيمية فإنهُ يُتَّهمُ بالتنظير للعنف.
أما في مدرسة الإمام عليّ فكلُّ الناس متساوونَ في الحقوق دونما تمييز، وعليهم واجباتٌ ومسؤوليات، وحقوقهم على قدر تحمُّلهم للمسؤوليات، وعلى مقدار الحقوق التي تتوجب لهم. فهناكَ مسؤوليةٌ تقعُ على عواتقهم أمام الله وأمام الناس وأمام أنفسهم. وهكذا تُلاحظونَ أنَّ هناكَ ارتباطاً عقائدياً بينَ مُقارعة الظلم والدفاع عن حقوق الناس، وطريق الله والشهادة في سبيله. وهذا تعريفُ المجتمع الديني الذي تحدّثَ عنه أمير المؤمنين نقلاً عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وهو أنَّ المجتمعَ الديني يَسْهَلُ فيه أخذُ حقِّ الفقراء والضعفاء دونَ خوفٍ أو وَجَلٍ من الأقوياء.
إلهية حكومة الإمام علي عليه السلام
ونُقِلَ عن الرسول الأكرم بما هو مضمونه إنهُ قالَ: لا أحدَ كعليّ قادر على إيجاد مثل هذه الحكومة والتعامل مع المجتمع، ولذا فإنَّ الله عزَ وجل اختاره خليفةً من بعدي، وقد أعلنَ ذلكَ الرسولُ في غديرِ خُمْ للناس أجمع بالقول عليٌّ أقواكم على هذا الأمر. أي أنهُ الأقدر على خلق نظامٍ اجتماعي، ونظامٍ حقوقي وحاكميةٍ تُراعى فيها حقوق الناس والمحرومين بِيسر، ويكون فيها الجميع مُحترمين، ولن يستطيعَ أحدٌ أن يقومَ بذلكَ غيرَ عليّ عليه السلام، وعليه فَلَهُ حقُّ الخلافة وقد نُصِّب لذلكَ من قِبَلِ الله سبحانهُ وتعالى.
وعليه فإنَّ حقَّ الولاية والتنصيب الإلهي، مِلاكهُ الوفاء لِحقوق الناس. والعمل على الوفاء بالأخذ بيدِ الناسِ للكمالات الدنيوية والآخروية. ولقد دعا هذا المنطق الإمام علي عليه السلام للتعبير عن ذلك في الخطبة المئة والثانية والثلاثين الواردة في نهج البلاغة حولَ الحكومة. بالطبع وَرَدَتْ مثلُ هذه التعابير في أماكن أخرى عن صفات القائد الإسلامي: (وقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ وَالمَغَانِمِ وَالاَحْكَامِ وَإِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ، فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ، وَلاَ الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ، وَلاَ الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ، وَلاَ الحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْم، وَلاَ الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَيَقِفَ بِهَا دُونَ المَقَاطِعِ، وَلاَ الْمَعطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الاُمَّةَ)[4].
وفي روايةٍ أخرى يُشيرُ إلى شِرار الحُكَّام وأصحاب المناصب من عِندَهُ حُبُّ الفخرِ، أي حُبُّ الشُّهرة والجاه حيثُ يَرونَ في أنفسهم أنهم أعلى من الناس، ويؤكدُ أنهُ لا يحقُّ للحاكم أن ينظُرَ للناس نظرةً استعلائية أو نظرةَ تحقير، وأنهُ لا يحقُّ في الحكومة الإسلامية للمسؤولين أن يكونوا مُحبينَ للفخر. ويُضيفُ أنهُ لا يستطيعُ أن يتعاملَ مع حُكَّامٍ مُتكبّرين، فيبدأ بِإصلاحهم وإن تَعذَّرَ ذلكَ عزلهم. ثُمَّ التفتَ إلى الناس ووبَّخهُم بالقول إنهُ يُطيعُ الله ولا أحدَ يُطيعُه، وأمَّا عدوه فإنهُ لا يُطيعُ اللهَ، لكنَّ أتباعه يُطيعونه.
الحكومة الأخلاقية والعلمانية
ثُمَّ يقول لا أدري بأيّ نيَّةٍ بايعتموني؟ إنَّ حكومة القيَم والعدالة تنشد العدالة الاجتماعية وينبغي أن يكونَ الحاكم حافظاً للقيم الدينية والإنسانية. وعليه ينبغي التصدِّي للأقلام التي تقول: إنَّ الحاكمية لا يمكنها ولا يسعُها أن تكونَ حافظةً للقيَم الفردية والاجتماعية التي جاءَ بها الإسلام، وإنَّ هذه الأمور تتعارضُ ونطاق المسؤولية الحكومية. فالدولة ليست حارساً للقيم ولا مسؤولةً عن ذلك، والحكومة ينبغي أن تكونَ الشُّرطي الذي يبسط الأمن والاستقرار. وعلى الحكومة أن تحافظ على حرية المنافسة في الميدان الاقتصادي والسياسي والثقافي، وتُوفِّر الأمنَ من أجل مراقبةٍ حُرَّة ودونما قيدٍ أو شرط للحدود الأخلاقية والفكرية. وليست مسؤولةً للدفاعِ عن الحقائق في إطار الثقافة، ولا مسؤولةً للدفاع عن القيم في إطار الأخلاقيات الاجتماعية، وليست مسؤولةً عن تطبيق العدالة في نطاق الاقتصاد والسياسة والحقوق الاجتماعية. بالطبع فإنَّ الحقوقَ سَيتمُّ استثنائها هنا، ليسَ من أجل القيمة الذاتية للعدالة ومسؤولية الدولة في تنفيذها.
ويُشيرُ هذا المنطق إلى أنَّه على الحكومة أن تحفظَ الأمنَ والاستقرار لِأصحابِ الثروة خلافاً للإيمان والإنسانية والمذهب، وأنَّ العاقلَ والحكيم لا ينبغي له أن يأخُذَ على الدولة طريقةَ حفظها للأمور حتى ولو كانَ بأساليبَ مغلوطةً وعجيبة. وهُم في ذلكَ يُفلسِفونَ المنهجية على الطريقة التالية: فلو أخطأ رَجُلُ السياسة في الأسلوب، فإنَّ عدمَ تقواهُ في إنجاز الأمور غيرُ مُهمٍّ إذا ما كانت النتيجةُ أن حَصَلَ على القُدرةِ واعتلى الكُرسي، وأنَّ الجماهيرَ والرأيَ العام سيغفر له ذلك، وأنَّ الأخطاءَ ستُغتفرُ بالنتائج، وعليه فليفعل الشخصُ ما يُريد، وليصِلَ السلطة بأيّ طريقةٍ كانت. القضية الوحيدة هي الرأي العام الذي سينسى هذا الأمر، حيثُ الأهميةُ تكمنُ في النتيجةِ لا في الطريقة.
هذه هيَ نظرياتُ الساسة في الغرب وصُنَّاع العلمانية من ميكافيلي إلى من تَبِعَهُ وحتى يومنا هذا. حيثُ تكثرُ مثلُ هذه الأفكار، فالأساسُ عندهم أن لا تترُكَ المُلاحظات القيَميَّة أثراً على قرارات الحكومة، لأنهم يَرونَ أنَّ الشخصية الأخلاقية لا يمكنها أن تُشكل الحكومة، وأنها لا تستطيعُ المُحافظة عليها. وعليه ففي حُكمِ هؤلاء تكونُ الأخلاقُ منفصلةً عن السياسة والديانة عن الحكومة، فالعمليةُ بحاجةٍ إلى احتيالٍ وتظاهُرٍ وخداع الرأي العام خاصةً في النظام الجمهوري، حيثُ ينبغي جمعُ الآراءِ بأيةِ صورةٍ كانت، والمسألةُ المُهمَّة تكمنُ في عدد الآراء لا نوعيتها، وعليه فهُم يَرَونَ أنَّ الأكاذيبَ المُنمَّقة التي يُطلقها الحُكَّام هيَ ضرورةٌ وعمليةٌ لازمة، والذكي من يكذب بصورةٍ ماهرة، وليسَ مُهمَّاً أن يكون الحاكم صادقاً أو كاذباً المهم أن يُحافظ على السلطة ويصل إليها. ولا ينبغي قياس القوة مع المعايير الأخلاقية، أو مع المعايير الدينية أو القيَميَّة، ذلكَ أنَّ القيم تابعةٌ لنطاق الخصوصية الفردية، وعليه فإنَّ الحكومة لا تستطيعُ أن تكونَ الحَكَمَ في مثلِ هذه القضايا العامة.
هذه باختصار مباني الفكر العلماني، وهيَ على النقيض من فكر الإمام علي عليه السلام، وعندما نذكرُ الفكر العلماني نقصدُ به الرؤى السلطوية والتوتالية والاستبدادية العلمانية، وهي التي كانَ أمثالُ ميكافيلي وتوماس روبرت مالتوس مؤيدينَ لها. أو الأنظمة العلمانية الليبرالية التي كانَ مُنظِّرُ المجتمع المدني في السنن الليبرالية من مؤيديها بدءاً من جون لوك وما بعدهُ حتى مُنظّري الليبرالية الحديثة المُعاصِرين. لقد ادّعى أعقابُ هذا الرأي في الفترات المتأخرة، وتحديداً العقود الأخيرة، أنهم وجدوا طريقاً أقصر لإعادةِ تشكيلٍ وإصلاح أكثرَ راديكالية في الحكومات التقليدية، وأعلنوا أنَّ ذلكَ يتمُّ فقط عبرَ إعادة النظر في جذور الحقوق والأخلاق، لا بل إعادة النظر في جذور اللغة والفهم الشعبي، وكانَ عليهم اقتلاع جذور الأفكار القديمة في باب العدالة الاجتماعية والقيم التي كانت مُعَشْعِشَةً في ذهن البشر، ذلك أنَّ مشكلة البشر الطبيعية تكمن في إِبهام اللغة وانحرافها، وأنَّ المشكلة الرئيسية تكمن في ماهية المُصطلحات، والمُصطلحات القديمة كالعدالة. وينبغي إحالةُ هذه المصطلحات القديمة على التقاعد وتهميشُها، وهيَ كلماتٌ تقليدية، والإتيانُ بمصطلحاتٍ حديثةٍ بدلاً عنها، وتقييد المصطلحات القديمة فهيَ مفاهيم تُزاحم الحاكمين، وهيَ معايير تُشكّلُ خطراً على الحكم. ويستمرُّونَ بترديد مثل هذه الشِعارات، ليقولوا إنَّ الخطأ ناجمٌ عن تعابيرَ قديمةٍ ومغلوطة، وإنَّ الكثيرَ منها استُلَّ من نظريات الفلاسفة التحليليين والاتجاهات المنطقيّة في باب حقوق الإنسان. ويمكنكم متابعة ذلك لأنني سأعمدُ إلى إعطاء رؤوس أقلام، وإذا أحببتم العودة فيمكنكم مُشاهدةُ طريقة رؤية هؤلاء إلى مسألة العدالة والقيم. حيثُ أبدلوا ذلكَ إلى نِزاعاتٍ لفظية، وإنَّه على الحكومات أن تكونَ قِيميَّةً وأن تتصرف وفقاً لذلك، كُلُّ ذلكَ نقضٌ لِعلم الاقتصاد وعلم السياسة.
انكار القيم المعنوية في السياسة والاقتصاد
إنَّ الاقتصاد الكلاسيكي الذي تدرسونهُ في الجامعات يقصدُ ذلك، وأننا لن نجرؤ على دركِ أساس ما يذهبونَ إليه، ولا نجرؤ على نقضهم في القريب العاجل. ذلكَ أنَّ النظام التعليمي قائمٌ على أساس التقليد والترجمة، وليسَ قائماً على الاجتهاد والابتكار والإبداع. لقد كتبوا في مباحثهِم، وقد وقفتُ على آرائهم بالتحديد، ينبغي عدم التحدث عن كتابة إعلانٍ لحقوق الإنسان، لأن ذلكَ سيؤدي إلى إضافة أعباءٍ جديدةٍ للحكومة من خلال إيجاد حقوقٍ وصفوها بالزائدة للطبقات الفقيرة والمسحوقة في المجتمع، وهذه ستكونُ مشاكل جديدة ومن ثَمَّ ستؤدي إلى تحريك الشارع، وكُلُّ هذه الشعارات والتدابير والتعابير عبارةٌ عن مصطلحاتٍ لما بعدَ الطبيعة. أي إنها تعابيرٌ لِمُصطلحاتٍ أيديولوجية ولا ينبغي الاتيان بها في نطاق السياسة وإدارة الاقتصاد، وهذه التعابير ما بعدَ الطبيعة إنما هيَ فقراتٌ أضافها الفقراء والضعفاء يُساندُهُم عددٌ من المؤمنينَ الرجعيين، شُعراء المسلك كي يقفوا قُبالةَ التقدُّم. الحقوقُ في منظارهم عبارةٌ عن قراراتٍ وعقود، وسيتمُّ تعريفُ الحقوق وفقاً للاتفاقات ولا ينبغي أن تكونَ الاتفاقاتُ مبنيةً على أساس الحقوق الحقيقية للشعب، أو أن تكونَ ملاكُ حقوقه، أي إنَّ الشعوبَ لم يكن لها حقوقٌ بالمطلق قبلَ هذه الاتفاقات وعندما وضعنا القوانينَ أصبحَ لهؤلاء حقوق، وأنَّ المُقنّينينَ الدينيين جاؤوا وأعلنوا منْعَ بعض الأعمال ووضعوا حقوقاً للشعب، ووضعوا الواجبات والتكاليف على كاهل البعض، ولغةُ العدالة والأصولية الدينية هي في ذاتها مشكلة، وأنَّ هذه الشعارات عبارةٌ عن أصواتٍ لا معنى لها.
ولو رجعتم إلى المباحث التي طرحها أصحاب المذهب المنطقي، لنظرتم أنَّ كُلَّ ما يقولونهُ هو عبارةٌ عن ألفاظٍ جوفاء، فهؤلاء يقولون إنَّ كُلَّ الأمور القيَمية والأخلاقية، وكُلَّ الأمور ما بعدَ الطبيعة عبارةٌ عن كلامٍ فارغ، فهؤلاء يقولون إنَّ المعنى الواقعي للمسميات يكمن فقط في الرِّبح، وعندها تكون كُلُّ المباني الحقوقية والأخلاقية والعدالة أموراً لا معنى لها، لا بل حتى يتمَّ النظر إليها بريبة. وهذا الأمر يُعدُّ خطراً كامناً بالنسبة لثورتنا، ونحنُ آخرُ مقطورات الثورة وآخرُ حلقة الجيل السابق. نتحدثُ إليكم لِنوصِلَ لكم هذا النداء، نحنُ بمثابة ساعي البريد عندما يُنهي أحدنا دورهُ يُسلّمُ البريدَ للآخر ليواصل المشوار وصولاً إلى الهدف، وهذه آخرُ النداءات من جيلٍ سينتهي إلى الجيل الجديد. فإن تلقيتم الرسالة تلقيتموها، وإلا فإنَّ البريدَ سيسقطُ أرضاً، حذاري من وصول الثورة إلى هذا المطب وسيحصلُ إن لم تمنعوا ذلك.
إنَّ من يروّجُ لمثل هذه الأفكار ويُترجمها في ذهن البشر، أُناسٌ قشريونَ وجامدون، وقد ألحقوا الضرر بالبشرية على الدوام، ولم يتعرف هؤلاء على القيم المعنوية ولو لمرّةٍ واحدة، ومن لا يعلم أنَّ تجمُعاً غيرَ مشروطٍ لرؤوس الأموال الكبيرة ولِأغراضٍ شخصية، ولِصالحِ أقليّةٍ فاسدة لم يَقُم على غصبٍ وإسرافٍ وتبذيرٍ ورِبا، إنهُ عينُ النظرية الماتريالية التي جاءَ بها الغرب وزرعها في العالم. حتى إنَّ أربابَ الرأسمالية الليبرالية قالوها بصراحةٍ، إنهم يؤمنونَ بالتقادم المادي، وأنَّ الماتريالية كانت ذاتَ معنىً أول الأمر، أما اليوم فهي نظريةٌ بلهاء ورجعية.
خطر حذف القيم الثورية
واليوم عندما يتحدثُ أحدهم على مستوى المفاهيم السياسية الكبيرة، كالحكومة وفلسفة القدرة ويطرح مصطلحات العدل والقيم فإنهُ سيوصفُ بالمُغاير للمقاسات والمُواصفات الموجودة، وسيكون مثل هذا الشخص مُباح الدم في كُل أرجاء المعمورة. وهناكَ أحزابٌ غيرُ مرئيةٍ تعرفُ كيفَ تُجهِزُ على الحكومات الثورية، ولا تُبقي منها غيرَ الاسم والظاهر وتقوم بتغيير المحتوى وتختبئ خلفَ المقاسات الدولية، فهُم يُصرِّحونَ علانيةً أنَّ السياسة تعني القدرة لا الحقيقة ولا العدالة، ولا ينبغي علينا أن نخلطَ المباحث فيستطيعُ هؤلاء تزين أكثر الثورات دينيةً وتجفيفها وعرضها على المنابر، وعندها تصبح هذه الحركات الكبيرة موجودةً وغيرَ موجودة في أنٍ واحد مع كل التعاليم الكبيرة التي كانت تتمتع بها.
وعليه نعلم أنَّ تركيزَ مفاهيم الثورة والقيم التي نادت بها من أجل الإنسانية تُعدُّ الأهم، وإن لم يَقُم جيلُ الثورة الثاني والثالث بالدفاع عن القيم كما فعل أبوذر، فحتى لو بقيت الثورة مضموناً فإنَّ شكلها الظاهري سيتغير دونَ أن تشعروا بذلك، وتكون بمثابة بقاء ظاهر المَبْنَى على حاله لكنَّ سكانهُ تغيَّروا. المبنى الذي شيَّدهُ الثُّوار وناشدو العدالة والمجاهدون والشهداء. وقد باتَ تحتَ رحمة نيران الأعداء، ورويداً رويداً يتبدَّلُ سُكان المبنى ويُمْلَأُ بمُناهضي العدلِ والقاعِدِيْنَ ومُخالفي أصل نظرية تلك الثورة الدينية. وإذا لم نكن واعينَ وبمستوى المسؤولية، فإنَّ نظرية التناسخ المغلوطة في الأفراد ستصدق على الحاكمية والتجمعات البشرية. بالطبع مع تعابيرَ مجازية، وتكون الأرواح الشريرة ما قبل الثورة قابلة للاستدعاء والمُحاكاة من جديد ويُمكِنُها التوغل والنفوذ في جسم الثورات. وسَيَتِمُّ عندها إبدالُ مِقوَد المجتمع صوبَ نقطةٍ أخرى، وتبدأ العملية بزاويةٍ صغيرةٍ جداً، وكلما يمتدُ ضِلعا الزاوية تزدادُ الهوَّة، وبمرور الزمان تكونُ هذه الزاوية الصغيرة كبيرة، بحيث لن يبقى من الثورة حتى الاسم. وفي ظاهر الصورة كُلُّ شيءٍ في مكانه، لكنَّ الحقيقة لا شيء في مكانه، كُلُّ شيءٍ صحيح وكُلُّ شيءٍ مُدمَّر.
ولهذا السبب كانَ على الثورة الإسلامية أن لا تكتفي بتغير شكل النظام البائت، بل كانَ عليها أن تأتيَ ببرمجياتٍ جديدةٍ دينيةٍ وثورية، وذلكَ لِتُغيّر أساسَ النظام، وأن تُغيَّرَ رأسَ النظام وذلك لا يكفي، لأنَّ الثورةَ عندها ستحكم بذات القيم التي كانت موجودة قبل الثورة، أو سيعودُ شَبَحُها إلى داخل الحاكمية الجديدة وإلى داخل المجتمع والرأي العام والجامعات، وهذا ما يقوم به الأعداء الآن وسيعود الهاربون من الباب عبرَ الشبابيك والنوافذ.
إنَّ تغييرَ الفئة الحاكمة لن يكفي، ينبغي تغييرُ الطبقة الحاكمة، الطبقة التي تحكم المُجتمع الجاهلي، وطبقاً لذلكَ كانت تحكم، وبخلافه فإنَّ تغييرَ الرجال الأصليين دونَ البِطانة لن يفيَ بالغرض، وسَتُعادُ الكرَّة بعد فترة من الزمن مرَّةً أخرى. ينبغي عَمَلُ غَرْبَلَةٍ كما يرى الإمام علي عليه السلام وأن يتمَّ تغييرُ الأوضاع تماماً كما يقول عليه السلام، حتى يعودَ أسفلكم أعلاكم، وأعلاكم أسفلكم، فلا يصحُّ أن نقول من كانَ في مسؤوليةٍ في العهد السابق أن يظلَّ كما كانَ عليه وستحكم الطبقة العُليا، وبهذه الطريقة يَكْمُنُ خطرُ حذف القيم الثورية، وهذا يتكرَّرُ كلما قامت ثورة.
عندما تولَّى الإمام علي الخلافة في العقد الثاني بعدَ رحيل الرسول صلى الله عليه وآله، لَمَسَ هذه الفاجعة بكُلِّ جوارِحِهِ، وأرادَ أن يُصحّحَ الأوضاع وأرادَ تغييرَ النظام، لكنَّ حروباً ثلاثاً فرضت عليه، فَحَمَلَ أصدقاؤه السابقونَ السلاح بوجهه، لو كانت السلطة الحاكمة لم تَفْسُد بعد والكثير من رجالات السياسة مازالوا أُناساً طاهرين، لكنَّ طبقة النظام الحاكم موجودة فإنها ستُمسِكُ بِتلابيب الأمور وسيمكنهم ذلك من العودة إلى مقاليد الأمور، أي إنَّ أعداء الثورة سيقومونَ بهجومٍ مُضادٍ ضدَّ الثورة بعدَ عقدٍ أو عقدين من الثورة، ويكونُ هجومهم بواسطة القنابل الكيماوية، أي دونَ إحداثِ جَلَبَةٍ لا شظايا ولا دماء. حربٌ باردة دونما ضجيج، بواسطة برمجياتٍ، وهكذا تخلو الساحة لهم من جديد.
وأعيدُ هنا مرَّةً أخرى: الطبقة الحاكمة غير الهيئة الحاكمة، فالأخيرة عبارة عن رِجالات الثورة والقادة السياسيين الذينَ تُناطُ بهم مسؤوليةُ إدارة البلاد ويتَّخِذونَ القرارات، لكنَّ الطبقة الحاكمة هيَ المجموعة الاجتماعية التي لا تكون لها سلطةٌ اعتباريةٌ أو قانونيةٌ رسمية، لكنها في الحقيقة السلطة العملية النافذة، أي إنَّ السلطة تكون بأيديهم، لا بأيدي الثوار الذينَ يتولّونَ المناصبَ القيادية ويكونونَ على رأسِ هرم السلطة.
والنظام الذي تحدَّثنا عنهُ يعني أنَّ القاعدة وعلى عكس الواقع هي التي تحكم. لقد شهدت ثورتنا في العقد الماضي بعدَ الحربِ خاصةً في الفترة المعاصرة هذه الأمور، وعلينا أن نكونَ حذرينَ من عدمِ تكرارها ويقعُ أمرُ ذلكَ بأيديكم. فأنتم من يستطيع المشاركة في جنازة الثورة أو من يرفعُ علم الثورة المُرمَّل بالدماء من الجيل الماضي، حيثُ سقطَ لنا ثلاثمئة ألف شهيد، ويمكنكم عندها رفع هذا العلم على أعلى القمم. على أيةِ حال أنتم من يقع عليه حِملُ الأمانة إمَّا بإخلاصٍ وتفاني وإمَّا في تقاعسٍ وتقهقر.
لقد حدثَ هذا الأمر مع الإمام عليٍّ عليه السلام في صدر الإسلام، حيثُ كبَّلت هذه الأمور قدرة الإمام على الحركة رُغْمَ عظمته، وأرادَ أن يُنقِذَ ثورة النبي والهيئة الحاكمة من خلال الإعمار، لكنهُ لم يستطع تغييرَ الطبقة الحاكمة أو إصلاحها. فبعدَ أن بَذَلَ سَعْيَهُ وقدَّمَ القرابينَ والشهداء وأقامَ الفتوحات المختلفة، لكنه أُثقِلَ بالجِراحات، وباتت مقاليد الحكومة بعدَ الثورة تسقط بأيدي الطبقات الموجودة قبلَ الثورة، وظلَّت الأمور تسيرُ وفقَ ذات الأمور وذات الرؤى للقضايا ومن تلكَ الزَّوايا. لأنَّ الثورة وإصلاحها يُعدُّ طبقاً لتعبير الحكماء أمراً قسرياً، والقسريُّ خِلافٌ للطبيعة ومثلما هو حالُ تهذيب النفس حيثُ يُعدُّ أمراً قسرياً لأنهُ خِلافُ الطبيعة وعليه فهو صعب، والأمر الطبيعي هوَ نُزولُ الإنسان من الجبل، وعليه فإنَّ الدعوة إلى الغريزة والمساومة والخيانة وأمثالها تبدو سهلةً، ولن تحتاجَ إلى ثمن، لأنها قد تكون من طبيعة البشر، لأنهُ ينشدُ الراحة والاستقرار، فالإنسانُ يكونُ عندها مُطيعاً. أمَّا الدعوة إلى الانتفاضة والجهاد والمقاومة فهي صعبةٌ جداً، لأنها حركةٌ صوبَ الأعلى وسباحةٌ ضدَّ التيار، وعليه فالحركة القسرية خلافٌ للطبيعة والغريزة ولهذا فإنَّ الثورة وإصلاح أمرها يُعدُّ أمراً قسرياً مُخالفاً للطبيعة.
الحكم العادل للإمام أدى للانقلاب عليه
وكما هو الحال في تهذيب النفس، الذي يُعدُّ خلافاً للطبيعة فإنَّ تهذيبَ المجتمع يُعدُّ خلافاً للطبيعة، وعليه فإنَّ الكثيرينَ قد يرسبونَ في الامتحان، وهكذا نرى الكثيرين يدخلونَ المُعترك بحماسةٍ لكنهم يسقطون بسرعةٍ أيضاً. لقد جرَّبَ الإمام علي كُلَّ هذه الأنواع وكانَ أسيرَ هذه الأوضاع، وعندما تُطالعونَ نهج البلاغة، تَرونَ الكم الكبير من الشكوى من الأوضاع، حيثُ لم يكن الناسُ معه، وقد خذلوهُ وتركوهُ في المعركة وحيداً، وهؤلاء كانوا أنفسهم الذين تهالكوا لتقديم البيعة له، حتى أنهُ قال عليه السلام: إنهُ ظَلَّ تحتَ أيدي وأرجُلِ هؤلاء وقد تمزَّقَت ثيابُه، وهكذا داست الأقدام الحسن والحسين عليهما السلام.
هذا هو الوضع وهذه هي الأمة، لكنهُ عندما أرادَ تطبيقَ العدالة وأحسَّ البعض بمرارتها انقلبوا عليه، حتى إنَّ بعضهم خَرَجَ من الدين نِكايَةً بالإمام، وقد نكَثَ الكثيرُ منهم ببيعته، ومن لم يفعل تركوني وحيداً في القتال كما يقول الإمام. وهكذا بقيت حربُ علي لإحقاقِ عدالة غيرَ مكتملة، وقد أدَّت إلى القضاء عليه لكنَّ الإمامَ استطاعَ خلال خمسةِ أعوامٍ من حكومته أن يقضيَّ على أعدائه طوال التاريخ في طريقة تعامله وشهادته، فلم یبق الإمامُ لهم أيَّ وجهٍ في التاريخ، وباتَ كُلُّ رَجُلٍ يقودُ الحُكمَ في المجتمعات الإسلامية أو الشيعية، تَتِمُّ مُقارنتهُ بما كانَ الإمام يفعل ويتصرَّف، خاصةً في عهدهِ إلى مالك الأشتر أو عبرَ نهج البلاغة، وإن لم يجرؤ أحدٌ على قولِ ذلكَ علانيةً، فإنَّ مشروعيةَ ذلكَ ستكونُ على المحكِّ في قلوبهم. وعليه فإن لم يتم التغييرُ الأساسي في دين الأمة فإنَّ شعلة الثورة ستنطفئ بعدَ حين، ويعود خيارُ الأمر إلى البيروقراطية التي كانت لها أفكارٌ تُطبَّقُ على أرض الواقع قبلَ الثورة أي العلمانية والغربية، وتعود المؤسسات القديمة قبلَ الثورة إلى مواقعها بِمُسَمَّياتٍ متعددةٍ حتى يكونَ بعضها باسم الثورة، وتبدأ بمصادرة كُلِّ شيءٍ لِصالحها. ودُفعةٌ واحدَة نرى أنَّ الثورة الدينية والمُستضعفين والحكومة الدينية والمُجاهدينَ والشهداء باتوا تحتَ تصرُّف العلمانيينَ والرأسماليين، وتقعُ بأيدي من ثاروا ضِدّهم قبلَ عشرات السنين، وعُذِّبوا بِسياطهم وهُجِّروا وأُدْخِلُوا غياهب السجون، وفجأةً نرى أنَّ الحكومة الدينية موجودةٌ وغيرُ موجودة في آنٍ واحد.
وكذا حالُ الثورة أساساً موجودةٌ وغيرُ موجودة وهكذا شَعَائِرُ وشِعاراتُ الثورة، وتَخرُجُ الثورة عن حالة الدعوة والنظرية وتتحولُ إلى اسمٍ وتقليدٍ بمعنى العادة والتكرار، وليسَ بمعنى السُّنَّة التي نتحدثُ عنها في التعابير الدينية، وهكذا تتحولُ إلى اسمٍ مُقدَّس يعودُ إلى التأريخ والأمور الدينية والشؤون التنفيذية والأمور العرفية وغير المُقدَّسة التي ينبغي لها ألَّا تتدخل في الأمور الدنيوية خوفاً من تلوّثِها. وهكذا تتحول البدع إلى سُنَنٍ في المجتمع وتصبحُ السُّنَنُ الثورية بدعةً، عندها لا يجرؤ المرءُ على ذِكرِ شِعارات الثورة التي انطلقت من أجلها، ومن أجل إيجاد مخرجٍ يظلُّ أمامنا طريقٌ واحدٌ لا غير، وهوَ ما فعلهُ الإمام علي وهو العودة إلى أُصول الثورة بأيّ ثمنٍ كان، ولن يكونَ هناكَ طريقُ حَلٍّ آخر. فإن عَرَّفنا الدينَ على أنهُ دعوةٌ كُبرى، وقبلَ أن نَصِلَ بهِ إلى السُّنَّة بمعناها الاجتماعي غير الديني – ولا أقصدُ هنا السُّنَّة بمعناها في العصمة والتي تَحْمِلُ في طياتها طراوةً دائمة- عندها سنتوصَّلُ إلى أنَّ المفاهيم الثورية والإسلامية ستكونُ حتى الثانويةِ منها تحتوي على أنجع الحلول الدينامية لطرح الأفكار الجديدة والطازجة، وإيجادِ حالةٍ جديدةٍ في المُجتمع الإيراني في العقد الحالي من عُمْرِ الثورة وهذا الأمرُ يُعَدُّ توجُّهاً ضدَّ الأصولية المُتلكئة عندَ الشيعة. عندها سيتبينُ لنا أنَّ الفقر الموجود والتفرقة السياسية والفاصلة الطبقية الموجودة في المجتمع ما هي إلا نتيجةٌ لشيءٍ واحد، الثورة التي قمتم بها من أجل العدالة والحكومة التي تشكَّلت من أجل العدالة، والعدالة في إطار الإسلام والروح الثائرة للإمام الخميني العظيم، وعقلانية التشيُّع والتي نُتابِعُها إلى يومنا هذا، مع كُلِّ هذه الإنجازات التي نَسْرِدُها.
عندما تَصِلُونَ اليوم إلى النضوج السياسي الاجتماعي، كيفَ لكم أن تواصلوا الطريق، وكيفَ سيكونُ حالُ الطبقة الجديدة والنواقص التي تُعاني منها، حيثُ واجهتنا في العقد الأول بعدَ الحرب المفروضة، وظهرت في السنوات الأخيرة في اقتصادنا وثقافتنا وسياستنا وامتدَّت كالأخطبوط، حيثُ أُقيمت العلاقات مع نُظُمِ ما قبلَ الثورة، وأقيمَ الحوار مع المفاهيم الغربية وتفاهمت معها حتى كادت أن توجِدَ لنفسها مكاناً في الحاكمية. كيفَ يمكنُ لنا كَبْحُ جماحِ هؤلاء؟ وأن نكونَ خاضِعينَ جميعاً للعدل العلوي؟ وكيفَ نستطيعُ وبواسطة أيّ نوعٍ من كشَّافة النُّظُمْ الشيعية والإسلامية أن نقفَ بوجه أنواع الاستبداد بدءاً من القروي والبدوي والمدني الحضري والمُعقَّد والشفاف؟ وترى أنَّ بعضَ المُبشِّرينَ لهذه الأنواع من الأفكار المُستبدة هُم مُسلِمونَ سابقون كانوا أنفسهم في طريق مكافحة هذه الأفكار، واليوم تحوَّلوا إلى حَمَلَةٍ لهذه الأفكار وليسوا قِلَّةً أولئكَ الأشخاص، الذينَ ذهبوا لمواجهة هذه الأفكار وعندما فشلوا لِخوائِهُمُ الذاتي غيَّروا جُلُودَهُمْ.
ذاتَ يومٍ قالوا إنَّ أحد المُقاتلين انفصلَ عن مجموعته وبعدَ يومين اتصلَ عبرَ اللاسلكي مع قائدهِ ليقول لقد أسرتُ أحدهم. فقالوا له: احمل أسيركَ وتعال. فقالَ إنهُ لا يأتي. قالوا له: ارجع بنفسكَ إذن، قال: لن يسمحَ لي. فقال له يبدو أنكَ أصبحتَ أسيراً ولم تأسر أحداً. هذه هي حالة الأفراد الذينَ ذهبوا ليأسِروا الأعداء واليوم يتصلون ليقولوا لنا إنهم لا يستطيعونَ العودة ولا يأتي من شَغَلَهُم. ويُعلِنوا أنهم تابوا عن القيم الأيديولوجية والثورة، وقد تخطوا سنَّ الرُشد وتخطوا سنَّ الطفولة، فهم يضحكونَ على كُلِّ القيم التي ضحوا من أجلها وسقط الكثير من الشهداء والشرفاء من أجلها.
الحاكم ليس عبداً للناس ولا هم عبيداً له
لاحظوا كم هي صعبةٌ الظروف التي مرَّ بها الإمام علي بعدَ أن أصبح حاكماً وخليفة، كانت أصعَبَ بكثيرٍ من جهاد الإمام عليّ إبَّانَ شبابه والغزوات والحروب التي شاركَ فيها للقضاء على الكفَّار والمُشركين وأشرافِ قُريش. هناكَ كانَ تكليفُ الإمام مُحدَّداً وواضحاً وفي معركة الخندق عندما عَبَرَ عمرو بن ود الخندقَ وطلبَ مُبارزاً، خافَ جميعُ المُجاهدين ولم يَقُمْ له أحد، إلَّا علي قامَ وأجلسهُ النبي مرتين، وفي المرة الثالثة قامَ وانطلقَ لمُبارزة عَمر بعدَ أن أذِنَ له الرسول، وتمكنَ من التغلب على هذا الفارس العتيد، ولم يشعر بالخطر الداهم حولهُ في مُبارزة ابن ود.
لقد قالت الزهراء بعدَ عشرة أيام من وفاة الرسول في الخطبة الفَدَكيَة بالمسجد ما مؤدَّاه: لقد نهضَ عليٌّ لِمُبارزة عمرو وعندما خِفتُم جميعاً كُنتم مع القيم والمبادئ، لكنَّكُم خشيتم أن تُقتَلوا، لا يمكن الدفاع عن العدالة بالمجَّان. لقد كنتم أنصار العدالة بِلا استعدادٍ للدفاعِ عنها، وكُلّ ما حَصَلَ خَطبٌ أو خَطَرٌ أرسلَ الرسول له علياً، كانَ مِغواراً على الدوام. وذَكَرَ الإمامُ في نهج البلاغة أنهُ كانَ في الخطوط الأمامية للحروب والغزوات، وهو ابنُ الستة عشرَ ربيعاً حتى تجاوزتُ الستين، ولقد غيَّرت النبالُ ملامحي، ورغمَ كُلِّ هذه المصاعب والمصائب وقفَ عليٌّ كالطَّوْد الشامخ قُبالةَ الأعداء، وظلَّ يُكرِّرُ: والله لقد وقفت العربُ في جهةٍ وأنا في جهةٍ، لن أهابَهُم، لأنَّ العديدَ ليسَ مُهمَّاً بالنسبة لي.
وقد ظلَّ الإمامُ وحيداً إبَّانَ حكومتهِ وكانَ يذهبُ وحيداً مُنتصفَ الليل ويبكي عندَ الآبار ويشكو همومه ويقول بما هو مضمونه: إلهي اصرِف عني شرَّ الأصدقاء، أمَّا الأعداء فإني كافٍ لهم، أدعوكَ يا ربِّ لِتدفعَ عني شرَّ الأصدقاء، أخشى أن يطعَنوني من الخلف. فبعدَ أن تسلَّمَ الإمامُ الخلافة ووقعت عليه المسؤولية المُباشرة للأمة، عَمَلَ ليلَ نهار على إحقاق العدل وباتَ مسؤولاً عن الأمة أكثرَ فأكثر، وبدأ بالحديث عن تطبيق العدالة وهوَ يعرفُ أكثرَ من غيرهِ أنَّ الحاكم عندما يتحدَّثُ عن العدالة فإنَّ ذلكَ سيوجِبُ عليهِ مسؤولياتٍ جديدة. عندما عيَّنَ الرسولُ بعدَ فتحِ مكة شاباً ليرأسَ الأصحاب تعجَّبَ الجميعُ وقالَ البعضُ: كيفَ يستبدلُ رسول الله شاباً ونحنُ أصحابهُ السابقون؟ لقد فَعَلَ الرسول ذلكَ لأنهُ مِّمَن يُريدُ التجديدَ بالشباب وكانَ مُحبَّاً لهم. وكما هوَ معلومٌ فإنَّ الشبابَ قلما يُسيسُون الأمور وهم أكثرُ صِدقاً في التعامل مع القيم والمبادئ. وقد فَعَلَ الإمام علي ذاتَ الشيء، فقد وجَدَ شباباً غيرَ معروفين، وبَعَثَ بعضهم لِإدارة الأمور في إيران واليمن ومِصر، ولم يوَّلي بعض الكبار في السن الذينِ كانوا من الأصحاب ومن شاركَ في الحرب إلى جانب الإمام وكانوا ممن يَرون في أنفسهم جدارةً للقيادة والخلافة، لم يُعطِهم حتى رئاسة البلدية في البصرة أو الكوفة، بعدها اندلعت الحروب ضد الإمام علي عليه السلام.
لقد كانت سيرةُ الإمام علي خلافاً لِكُلِّ الدبلوماسيات الرائجة في العالم، من قديمها إلى جديدها، من شرقها إلى غربها، لأنهُ كانَ يعلمُ أنَّ ساسة الدنيا يُفكِّرونَ بغير الطريقة التي يراها مناسبةً لتطبيق العدالة. ربما كانت خِطاباتهم مُختلفةً لكنهم كانوا يحكمونَ بشكلٍ مُتشابه. لكنَّ الإمام عليّ كانَ يُفكِّرُ بطريقةٍ أخرى ويحكم بطريقةٍ أخرى، ولذلكَ نَصَبوا له المكائِدَ والعداء.
بالطبع فإنَّ طريقة تعامل الحكام مع الرعية مختلفةٌ من مكانٍ إلى مكان، فالبعضُ يتحدَّثونَ مع الرعية بطريقةٍ بلهاء، والبعضُ بصورةٍ مُعقَّدة، والبعضُ يحكمونَ الناسَ دونَ أن يتحدثوا إليهم وهي أكثرُ أنواع الحكم سفاهةً. وهذه الطريقة خِلافاً إلى ما ذهبَ إليهِ الإمامُ علي عليه السلام، فعندما أرسلَ مالكاً إلى مصر وشمال أفريقيا يقولُ له: تحدَّث مع الرعية وكن بينهم، ولا تُقِمْ الفواصل معهم، فلو شكَّ الناس بك وتحدَثوا من خلفك، لا تسكت، اذهب إليهم وتحدَّث لهم، كُن صادقاً معهم مثلَ كف اليد، قُل محذوراتك للناس، تكلم عن مشاكلكَ، اعتذر منهم. لقد قالَ الإمام للناس إنني أخدمكم، لكنني لستُ عبداً لكم، وأنتم كذلك لستم عبيداً لي، لكنَّ العالمَ اليوم ليسَ هكذا، فكلُّ الناس عبيدُ الحكومات والمُرائينَ يُريدونَ ركوبَ الناس بطريقةٍ مُعقدة، حيثُ يقولون أيها الناس نحنُ عبيدكم، لكنهم يفعلونَ ما يُريدون.
إنَّ علياً قالَ للناس لست عبداً لكم، ولستم عبيداً لي، أنا وأنتم عبيدٌ مملوكونَ لرب العالمين، المُلكُ لله، وإنني مسؤولٌ قُبالتكم لأنَّ الله أرادَ لي ذلك، وسأوفي بعهدي حتى وإن أدرتم لي ظهوركم، إنني سأعملُ بالتكليف الذي يوجِبُ عليَّ خدمتكم، ولو خاصمتموني فإنني لن أفعل، سأعملُ بالتكليف. فعندما لا يكون الحكم لي وتتركوني وحيداً فإنَّ تكليفي سيكونُ محدوداً، ولكن عندما أكونُ حاكماً وتأتونَ لبيعتي فإنَّ التكليف والواجب سيختلف، ولكن على أية حال فإنني سأقومُ بعملي وواجبي ولن أفعلَ ذلكَ من أجلكم فلستُ عبداً لكم ولستم عبيداً لي.
[1]– شرح نهج البلاغة (ابن ابي حديد)، المجلد: 17، الصفحة: 85.
[2] – الكافي: 1 / 89، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني، المُلَقَّب بثقة الإسلام، المتوفى سنة: 329 هجرية، طبعة دار الكتب الإسلامية، سنة: 1365.
[3] – وسائل الشيعة ط-آل البیت العلامة الشيخ حرّ العاملي ج : 15 ص 122 : رواه أبوداود رقم الحديث:(4772)، ورواه الترمذي رقم الحديث: (1421).
[4] – نهج البلاغة، الخطبة: 131.
المصدر: رابطة الحوار الديني للوحدة












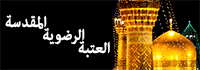

تعليقك