وكالة أنباء الحوزة ـ ألقى الأستاذ حسن رحيم بور أزغدي محاضرة تحت عنوان حاكمية المجتمع الديني، مقدماً تعريفاً واضحاً لهذا المجتمع، ثم تناول في بحثه الشريعة الإسلامية ونظرتها إلى مختلف جوانب حياة الإنسان، والمجتمع الديني، وشروط الحاكم فيه، وفيما يلي نقدم لكم نص المحاضرة:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد (صلی الله عليه و آله).
بناء المجتمع الديني
أبدأُ حديثي معكم بمقدمةٍ بسيطةٍ وفي ذات الوقت مُهمَّة، ويبدو أنها مغفولةٌ على الدوام، فلو سألنا عن الإطار والقالب الأصولي الذي ينبغي بناءُ المجتمع الديني عليه حتى يتمتع بالاستقرار العقلي والضرورة الدينية، وهذا لا يعني أنَّ المجتمع الديني مجتمعٌ مُعدٌ سلفاً وكأنه وقعَ من السماء وجاءَ ليجلس في مكانه، ولا يبقى أمامنا غيرَ أن نعيشَ وسط هذا المجتمع.
إنَّ للمجتمع الديني تعريفاً دينياً مُحددًا وواضحاً، وهذا في الواقع ما يُميّزُنا، حيثُ ما نزالُ نُفكرُ في ذيلِ الفكر العلماني، والمجتمع الديني يُصاغُ في ذيل الاجتهاد والحركة وهو بحاجةٍ إلى تنظيمٍ عُقلائيٍّ، وهذا هو عمل البشر وهذه نقطةُ التمايز بيننا والقدماء المُتحجرين. ويعلم الأخوة والأخوات أنَّ الوصولَ إلى نصابٍ معقولٍ من المجتمع الديني دونَ تشكيل الحكومة الدينية يُعدُّ من الأمور المستحيلة. إنَّ إمكانيةَ وجود المجتمع الديني دونَ إمكانية الوصول إلى القدرة لتطبيق الأحكام الاجتماعية للدين يُعدُّ من الادعاءات ليسَ إلَّا. وفي ذات الوقت علينا أن نعرفَ أنَّ بناءَ مجتمعٍ دينيٍّ ليسَ أمراً حُكومياً صرفاً، وليسَ صحيحاً أنَّ بناءَ نظامٍ على أساسٍ ديني يتمُّ بصورةٍ أوتُوماتيكية، وكأنَّ الموضوعَ عندَ الطلب. وأن نقولَ للحكومة افعلوا ما يحلو لكم وسنعيشُ حياتنا بصورةٍ مُستقلّة، ولعيشَ كلٌ حياتهُ مثلَما يُريد. علينا أن نُراقب الإفراطَ والورطتين النظريتين، وهيَ في باب النسبة بينَ المجتمع الديني والحكومة الدينية.
إنَّ عدم امتلاك مجتمع ديني بدون حكومةٍ دينية وعدم الميل نحو الحكومة الدينية بلا مجتمعٍ ديني ليسَ مُفيداً ولا ممكناً ولا مرغوباً به، وهو يبدو كالمُلازمة أي أن يكونَ هناكٌ موائمةٌ بينَ المقولتين وهذا يعني أن يُكملَ أحدهما الآخر، أي المجتمع الديني والحكومة الدينية وليسا منفصلتين عن بعضهما. وعليه ومن أجل الوصول إلى نصابٍ أعلى، فإنَّ على المجتمع الديني أن يُجاهد َأكثر للحصول على مُدراءَ أكثر عقلاً وأكثرَ صدقاً وهو بحاجةٍ إلى برمجياتٍ أكثرَ تعقيداً ونظامٍ تعليميٍّ ووسائل إعلام سليمة. وهذه كُلها ملفات. على أية حال فإنَّ الحاكمينَ هم بشر والبشر إن أرادوا أن يحكموا بطريقةٍ دينية فهُم سيُخطِئون لا محالة، حيثُ قال الإمام علي عليه السلام: إنما الوالي بشر، أي أنَّ الحُكامَ والمسؤولينَ الحكوميين في الدولة الدينية بشر. ويُضيفُ عليه السلام: لا يعرفُ ما توارى عنه الناس به من الأمور. وهكذا تتضح الأخطاء البشرية إننا في حقيقة الأمر قاطعون في نظرية الحكومة الدينية، لكننا نَسبيونَ في تطبيقاتنا العملية لها، أي ينبغي القبولُ بالتدرُّج في تحقيقٍ كميٍّ ونوعي للمجتمع الديني والحكومة الدينية.
بالطبع هناكَ نصابُ الحد الأدنى، ولو كُنَّا أدنى من النصاب في حده الأدنى فلا يصحُّ أن يُطلقَ على ذلك المجتمع اسمُ المجتمع والحكومة الدينية. بالطبع يُمكننا إطلاقُ هذه التسمية مجازاً حتى ولو كانت كل الضوابط الدينية غيرَ مرعية ولم تكن هناكَ حكومةٌ تُعنى بأيٍّ من الأسس الدينية والعدالة الدينية، وهذا أمرٌ طبيعي، وإن فَشِلنا في برمجياتنا وتطبيقاتنا العملية في الحكومة الدينية، فإننا سنتلقى الضربات بنفس الدرجة. ما أريدُ التحدث عنه في هذه الجلسة هيَ تعاليم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم التي نقلها إلينا الإمام علي عليه السلام، حيثُ طبقها بحذافيرها على الواقع الاجتماعي، ليسَ خلالَ فترة حُكمه فقط التي استمرت خمسَ سنواتٍ، بل حتى قبل ذلك. أي في الفترة التي لم يكن يتملكُ فيها السلطة ولم يكن مُنفَّذَ العدالة الاجتماعية في المجتمع.
الإسلام والعلمانية في المجتمع الديني
وموضوعنا في هذه الجلسة هو هل يمكن تجزئة الحقيقة؟ الجوابُ: لا يمكن ذلك، لأن الأمرَ لا يشملُ إقليمينِ أو عدةَ أقاليم، ورُغمَ أنَّ الجوابَ مُختصرٌ إلا أنهُ كانَ محل نزاعٍ طويلٍ وموسَّع وهو اليوم َمحطُّ بحثٍ في علم السياسة وفلسفة السياسة وفلسفة الحقوق وفلسفة الأخلاق. إنَّ الدرسَ الكبير الذي يمكننا أن نستقيه من الإمام علي عليه السلام هُنا هو أنَّ الحقيقة الإيمانية لا يمكن فصلهُا عن الحقيقة المعرفية والعملية.
إنَّ الإلزامات الاجتماعية للمذهب تُعدُّ جُزءاً من لوازم حقيقية، لأنَّ التأثيرات الدنيوية والأخروية ناجمةٌ عن تصرفاتنا سواءً الفردية أو الاجتماعية، إنَّ الدنيا والآخرة مُرتبطتان بتصرفاتنا وغيرُ منفصلةٍ عن بعضهما، بالطبع من رؤيةٍ دهرية، وربما كان الأمرُ غيرَ مُرتبطٍ بين عالم الدنيا والرغبات الروحانية. وأن هدف الدين غيرُ مرتبطٍ بدنيانا، وهوَ غيرُ قابلٍ للتصوُّر، أي أنَّ الحقائق الربانية مُقدسةٌ بمقدار معناها المسيحي والكنسي لا بمعناها الإسلامي. أي أن يكونَ مُقدساً وفي ذات الوقت مُجملاً، وله عدةُ قراءات بحيث لا يجرؤ أيُّ عاقلٍ على الاقتراب منها. لكنَّ الوضعَ في المنطق الإسلامي يختلف، فالإيمان وبمقدارِ كونه حقيقةً وجوديةً فإنهُ حقيقةٌ معرفية، وبنفس الوقت حقيقةٌ عملية. وهذا هو فرقُ الإسلام والشيعة مع المسيحية، والدينُ بات في الواقع العملي سُنةً علمانية، وظلَّ حتى اليوم يواصل الجدل مع الإسلام. والمنطق الإسلامي لا يؤمنُ بالتمثيل وتجزئة الآدمي، فالإنسان ليسَ مجموعةً من الأجزاء المتوزعةِ حتى يصدقَ عليه اعتبار الوحدة، فالإنسان واحدٌ والمجتمع الإنساني كذلك.
الإنسان نفسٌ واحدةٌ بقوى متعددة، ميثاقٌ بوجوهٍ كثيرة، وهيَ وجوهٌ تتشابكُ فيما بينها، وعليه لا يمكن فصلُ إيمانه عن عمله، وأخلاقهِ عن اقتصاده، وحقهِ عن تكليفه، وعلمهِ عن اعتباره، وقيمهِ عن حقائقه، وتوصياته عن توصيفاته، ودينه عن دنياه، وفرديته عن مجتمعه، ومعاشه عن معاده. بل لا يجوز أصلاً فعلُ ذلك، فهوَ جريمة. فالتمثيلُ بشخصية الإنسان أمرٌ ينبغي متابعته قضائياً، لأنكَ في هذه الصورة تريدُ تمديدَ إنسان وتريدُ تقطيعهُ وأخذَ أبعاده واحداً تلوَ الآخر، وانتزاعها منه وتتحكم في مصيره. إنَّ المُنظرينَ العلمانيينَ يحاولونَ في حقيقة الأمر تقطيع أوصال الإنسان من خلال تفكيك أبعاده المادية عن أبعاده المعنوية، وهيَ إهانةٌ كبيرةٌ للإنسان عندما يتمُّ سلبهُ من روحانيته ورميُها كقطعةِ لحمٍ. وتقولُ لهذا الإنسان إنَّ دينكَ الذي تدينُ به لا يحقُّ له أن يتدخلَّ في إطار الحكومة والاقتصاد والحقوق والتكاليف. أي دعوا ما لِقيصرَ لِقيصر. وهكذا فصلوا الدين عن الدولة، وقالوا ليخرس الجميع. فعلَ ذلكَ الفاشيون والماركسيون والليبراليون وبهذه الاستدلالات الهوجاء وقفوا بوجه مشروع الأنبياء، وكانت النتيجة ما نشهدهُ اليوم من نظامٍ رأسمالي فاقدٍ للروح. فقد أصبحنا نحنُ الآدميونَ حيواناتٍ تسيرُ بأرجُلٍ نمضي دون أن نكشف معنى الحياة، ونسيرُ بكلِّ قُوانا إلى توفيرِ ظروف حياتنا، أي أننا لا نمضي باتجاه كشفِ معنى الحياة. لكننا نلهثُ وراء تأمين ظروف الحياة ونتحولُ رويداً رويداً إلى آدميٍّ تظهرُ حقيقتهُ في إطار القُدرة واللذَّة وحسب. وتظهرُ حقيقتهُ في السوق وتكون مقتنياتهُ من كلِ هذا العالم، التفنن والاستهلاكَ والهيجان. ورويداً رويداً يقومُ تغير قلبهِ بداخلهِ أي عواطفهِ بلذَّته، وتتبدل حضارته لتكون عبارةً عن أدواتٍ صناعية، وأدبهُ وفنونهُ إلى أفكارٍ نسبية، وعندها لن يكونَ هذا الإنسان مُستحقاً لعنوانه الإنساني، ويبقى الطريق الوحيد للتعرّف على طبيعة هذا الإنسان هو المُعاشرةُ والاحتكاك. وعندها يقعُ مجتمعٌ متكامل في هذا النوع من الفلسفة في دورةٍ انتاجيةٍ من أجل الاستهلاكِ، والاستهلاك من أجل الانتاج. وعندها يقع الإنسان أسيراً لدكتاتورية المكننة، واستبداد الأموال، ورؤوس الأموال، ونظام عبيدٍ جديد يَحفظُ علاقات نظام العبيد، لكنهُ يُحولهُ إلى علاقاتٍ وأطرٍ حديثةٍ ممكنة. وفي هذا المنطق تصبحُ الحياةُ عديمة المعنى، ثُمَ يتمُّ السعيُّ عبر الصحة والصناعة والمعلوماتية وتذويق هذا الإنسان إلى الموقع الممكن، أي نُحوّل أنفسنا إلى أزليين وأبديين، وعندما نفشلُ نشعرُ بالعبثية. في بعض الأحيان يتساءل الإنسان: هل هناكَ من فلسفةٍ لحياتنا أم لا؟ ربما يتوصلُ إلى أسماعنا هذا السؤال، وتارةً لن تسنحَ الفرصةُ حتى لذكر هذا السؤال، فنكون كاللذينَ يعيشونَ حياتهم دونَ فكرٍ ولا علاقةَ ليَّ الآن بالمجتمعات الفقيرة والمتخلفة، أولئك الذينَ يركضونَ وراءَ السَّراب قد خَسروا كلَ رؤوس أموالهم الوطنية، إنهم موجودونَ في المُجتمعات الغنية والصناعية الكُبرى.
اليوم ومن خلالِ مجموعةٍ من مفكريهم المخلصينَ في علم الاجتماع، الإنسان العصري باتَ عبارةً عن جهازٍ أوتوماتيكيٍّ فاقدٍ للأحاسيس، فالآدميُّ يقومُ بصناعةِ مكائن تعملُ كالإنسان، وتقومُ المكائنَ بدورها بصناعة أُناسٍ يعملونَ كالمحركات، ويتضاعفُ في هذه المدينة الفاضلة ذكاء الإنسان على حساب عقله، وفي هذه المدينة الفاضلة يتضاعف الضغطُ المعلوماتيُّ وترتقي المهارات الفردية، وينخفضُ ضغطُ المشاعر الإنسانية العميقة في قضايا الحياة الأصلية. وفجأةً ترى هذا الإنسان استطاع أن يتلقى أدقَّ التفاصيل والجزئيات الصغيرة، لكنهُ يظلُّ يعجزُ عن إدراك الحقائق الكبيرة والأساسية، وهكذا تنقلب الموازين ويُشدُّ السرجُ على الإنسان بدلاً من ركوب الإنسان عليه. وبناءً على هذا، على الإنسان أن يعملَ ويعمل، لكنهُ سيعجزُ عن إيجاد ِأي توضيحٍ لأفعاله، وفي النهاية لا يستطيعُ إيجادَ أي معنىً لنفسه، ويظلُّ الإنسان يلفُ حولَ نفسه. ويستطيعُ من خلال التقنية العالية أن ينقل أحجاراً كبيرة ولا ندري هل إنَّ هذه الأحجار هيَ لقبورنا؟ وهل أنَّ الأساليبَ أخذت مكانها محلَ الأهداف؟
وفي مثلِ هذه المجتمعات لا يستطيعُ أحدٌ ولن يحق له أن يقولَ ماهيَ الحقيقة؟ أي لن يكونَ هناكَ أحدٌ يمكن الوثوق بكلامه، أي أن يكونَ كلامه صحيحاً أو أن تكونَ كلمةُ نعم الصادرة عنه صادقة. ويتنامى هذا المنطق حتى يُصبحَ شيئاً يُسمَّى الحقوق، ويتم تناسي مسؤولية الإنسان تجاهَ أخيه الإنسان. وهكذا يتحولُ الإنسان المسؤول المتابع لهموم الأمة والإنسان الهدفي إلى إنسانٍ ينشدُ المزيد دونَ هدف وأناني. لا فرقَ بينَ الإنسان المؤمن والشكاك، ولا يعرفُ أيُهما أكثرُ إنسانية من الآخر. وفي ظلِ هذه التعاريف فإنَّ الإنسان الحر يُعدُّ كالثغر المفتوح الذي يُنادي بحقوقه، وما يطلبه الآخرونَ فهوَ عبارةٌ عن أشياء إضافية.
التعارض مع رسالة الأنبياء
أمَّا فلسفةُ تكليف الإنسان المرتبطة بالحقوق الممنوحة له في هذا العالم والتي تجعلُ له تكاليفَ مقابلَ ذلك، فهيَ مسحوقةٌ تحتَ أقدام الماتريالية الرأسمالية، وعندها تصبحُ الرذيلةُ عاديةً، والفضيلةُ أمراً مُهمَّشاً. وعندها يكون الإنسان الذي كان يُريدُ أن يَحلَّ محلَ الله سبحانه باتَ فجأةً في فهرس الزرافة والذباب، حيثُ يتمُّ عَدُّها. ولكن لأنَّ للإنسان قوىً حياتياً مُعقدةً نسبياً يُصارُ إلى التعامل معه بشكلٍ يفرقُ عن الباقين. ويتمُّ الحاقُ مُصطلح الحرية في نهاية كل شيء حتى يكونَ في حلٍ من كُلِ عقلانية ومسؤوليةٍ تحفظُ ماءَ الوجه. وحتى لم تنتفي القيمُ بصورةٍ صريحةٍ وأصوليةٍ في التجارة الحرَّة والإيمان الحر والأخلاق الحرة والمبادئ، لكنها ستكونُ بلا معنى، أي إنَّ المبادئ ستكون عُرضةً للتوالد من جديد وسيتمُّ لملمتها بطريقةٍ أو بأخرى. فلو قُدِّرَ للإنسان أن يضعَ المبادئ والقيم تحتَ رحمةِ المَقْصلة وتخلَّصَ منها دفعةً واحدةً، لكن أفضلَ من التشكيك بها أو جعلها نسبية أي الإجهازُ عليها، ذلكَ لأنَّ هذه الطريقة تُعّدُّ إعداماً مع الأشغال الشاقة.
في الثقافة الغربية تكون حياة الإنسان هي الهدف على عكسِ ما هو موجودٌ في سُنّةِ الأنبياء، ولأنَّ الحياةَ وسيلة الهدف هو الإنسان وليسَ الإنسان تحتَ أيةِ ظروفٍ كانت. إنَّ نظريةَ عدم الالتفات إلى الأحكام والحقائق، ودونَ الالتفات إلى العدالة والمُضي في الحياة الفردية دونَ اكتراثٍ بالآخرين، والسعي للحصول على الثروة والقدرة، تُعَدُّ الوجه المُقابل لنظرية الأنبياء. فلو كانت أمامَ الأنبياءِ رسالةٌ واحدة يُبلغونها للبشر لكان القولُ إنَّ هذه الطريقة الغربية الحياة البشرية غيرُ صحيحة.
إنَّ الشعار المطروح بأنَّ التنمية والحرية والمدنية والتطور هي الهدف، تبدو شعاراً غائياً من أجل أهدافٍ أخرى وعلى رأسها تهميشُ المسؤولية الإنسانية للإنسان. لقد ابتكرَ مُعارضو طريقة الإمام علي في الحياة طريقةً رخيصةً في التخلصِ من طريقة الإمام في الحياة. وهيَ الحديثُ عن الأهداف التي تُعدُّ واسطةً وليست أهدافاً غائية، وهيَ عينُ الفلسفة العبثية. بالطبع فجميع الأشياء هدفٌ لكنها ليست الهدفَ كُله. وهكذا فإنَّ التفاوت الرئيس بينَ المجتمع الديني والمُجتمع الغير ديني يكمنُ في أنَّ هؤلاء ينظرونَ إلى الأمور على أنها أهدافٌ وواسطةٌ وليست غاية. وهي دون الشأن الإنساني بتصورنا. وهيَ من حيثُ التأثير والصراحة قصيرة الأمد، وهي في ذات الوقت يمكنها أن تكون مؤثرة في جميع نشاطاتنا ولن تسمح للناس أن يتوجهوا إلى المجتمع الديني المتكامل، عندها يتحول المجتمع إلى صندوقٍ، إلى آلةٍ دونَما إحساسٍ ومشاعر، وستكونُ تلك الأربابُ وليسَ الإنسان وهذا خطرٌ كبير، وهذه من مخاطر التفكيك بين المادة والمعنى. وهناكَ مخاطر أخرى لأنهُ فكرٌ خاطئ وله عواقب كثيرة لا تظهرُ جميعاً، فهيَ دوريةٌ مَثلها كمثل مزرعة الأرز ينبغي أن تكون غاطسةً في الماء. فهؤلاء يقومونَ بغمر اللوازم والأدوات والنتائج بالمياه ليكونَ كلُ نتاجٍ مُعدَّاً للاستخدام في مآرِبِهِم. إن الثقافة التي تقول إنَّ القيَّمَ والمبادئَ لم توضع من قِبل الرَّب، وهيَ غيرُ مرتبطةٍ بالحياة الواقعية بل مرتبطة بأهواء وميول ِالفرد وحده، وليسَ علينا من فروضٍ غيرَ ما توجبهُ العقود الوضعية، فهو يُريد أن يقولَ إننا لا نملكُ واقعاً جيداً، أي ليسَ هناكَ واقعٌ ذو قيمة. وبعبارةٍ أخرى فإنَّ تصورنا للجيد والسيء عبارةٌ عن طبقٍ فارغ أي أنَّ قراراتنا هي التي تملؤ هذا الطبق وليسَ هناكَ أيُّ شيءٍ بعيداً عما نريدُ نحن.
إنَّ الرياحَ الباردة التي أتت على الأخلاقَ وظلت تؤثرُ على مفهوم الوجدان ومفهوم بديهيات الفعل العملي والنظري لقرنين من الزمان، وأصابتهما بالانجماد، نابعةٌ من هذا الطراز من التفكير الذي يدعو إلى المُثلة بالإنسان، وآنَ لها أن تزول. لم يكن أحدٌ ليجرؤ على فعل ذلك أي إنَّ أكاديميات علم الاجتماع وعلم الأخلاق باتت مرعوبةً، وهنا نذكرُ ما معناه ُ في قول الشاعر: كالبّبغاءِ تقولُ ما تسمع من دون أن تفقه ما يُقال، كالميتِ خلفَ جدار ما سمعوا بكم برغمِ كلامهم المُسال.
تحريف صورة الإسلام
لقد اعتدنا في أكاديمياتِ علم الاجتماع والعلوم الإنسانية على قولِ وسماع العديد من الجُمل المتكررة والمثالية، ويبدو أننا لا ننوي تركَ هذه العادة في القريب. في العلوم السياسية والاجتماعية والتربوية فإنَّ كُلَ ارتباطنا يقومُ على أساس الترجمة، ولن نجرؤ يوماً على الوصول إلى مرحلة البلوغ، ولن نجرؤَ على السؤال ولن نجرؤ على الشك فيما يُطرحُ من ترجمة. وفي الغالب وللأسف يبدو أنَّ علينا في جامعات الشرق أن نُكرِّرَ مقولاتٍ طُرحت قبلَ عُقودٍ وكأننا ظلُّ الجامعات الغربية. وما يزالُ هؤلاءِ أرباباً ونظلُّ نحنُ رعيتهم في الثقافة والعلوم. وإذا ما أخطأ أحدُ المُنَظِّرينَ في الأمور الإنسانية ووقعَ في التناقض في هذه العلوم فما علينا إلا أن نُكرِّرَ ما يقولهُ سمعاً وطاعة، وعندما يتحدثُ عن الفلاسفة الماديينَ في الغرب فعلينا أن نُكرِّرَ ما يقولهُ دونَ التوجُّه إلى لوازم ما يقول، وإذا قالَ ما يقولون إنَّ نتيجة العمل العلمي والسياسي تُغطي على سوء العمل نفسه ويتمُّ من خلال ذلكَ تبرئةُ مُنفِّذ العمل، ذلكَ أنَّ الناس يقومونَ وبشكلٍ تدريجيٍّ بالصفح عن مُرتكب الأعمال السيئة للنتائج التي تمَّ التوصلُ لها وينسَونَ ما حصل.
وينبغي ومن أجلِ إبقاءِ كيان الدولة فاعلاً إشراكُ عددٍ أكبرَ من الأفراد، ونقومُ نحنُ بكتابة التفاصيل عينها ولكن واضعينَ بسملةً في البداية مُتناسينَ أنَّ ذلكَ يتعارضُ تماماً مع التفسير العلوي مئةً في المئة. وهاتان مقولتان مُتباينتان ومُتعارضتان، فالحكومة من منظار أمير المؤمنينَ ليست شركةً كسائر الشركات، إنَّ الرؤية العلمانية للحكومة والمجتمع ستؤدي إلى مدينةٍ غيرِ المدينة الدينية وهاتان المقولتان منفصلتان عن بعضهما. وفي الثقافة العلمية لا يُمكنُ إرجاع الأخلاق إلى علم الاجتماع، ولا علم الاجتماع إلى ميكانيك الجسم والأعصاب. ولا يمكن تحريف الحقوق الطبيعية والحقوق الفطرية، ولا يمكن إرجاعُ السياسة إلى دبلوماسية القوة، ولا يُمكن اعتبارُ المُعتقد ما يتوصلُ إليه الدماغ والأخلاق على أنها بُخارُ المعدة، وتفكيكُ ذلك عن السلطة والدولة والبرلمان. فالرجلُ السياسي في تعريفِهم فنانٌ، والرجل السياسي والساسة هم مُتحدثونَ مَهَرَة، والسياسة تعني حُسنَ التلاعبِ بآراء العموم والكلابُ تَسيرُ وفقَ حاسةِ الشَّمِ وصولاً إلى ضالتها.
وعلى الساسة في نظريةِ هؤلاء أن يكونوا كالكلاب، وعليهم أن يعرفوا عن أي موضوعٍ وفي أي وقتٍ يتحدثون وأيُّ حديثٍ ينسونَ أو يتناسون. عليهم أن يكونوا مُخططين دونما غايةٍ عقليةٍ أو أخلاقية، وعليهم أن يعرفوا جيداً كيفَ يصعدونَ السَّلالم، وعلى من يرتقون، وألا يُسحبَ البساطُ من تحتِ أقدامهم. وعندما تقولُ لهم ما هوَ مصيرُ المبادئ التي تحدثتم عنها مُسبقاً وما هوَ تكليفُ القوانين الإسلامية، وما هوَ تكليفُ ما ثُرْنا من أجله؟ يقولونَ لكَ إنَّ زمنَ الأكاذيب الكُبرى قد ولَّى، وعلينا أن نُعيدَ حِساباتنا. وليسَ من المفروضِ على الإنسان أن يتحدثَ عن الأصول المُتعالية بهذه الطريقة، ويبدؤون بالحديثِ ساعاتٍ عن عجز الإنسان وعدم استطاعته، ويُشككونَ عندما يكون الحديثُ عن الأصول، وعندما يحينُ الكلام عن المتعة والاستفادة من القدرة فإن الشكَّ لن يُساورهم على الاطلاق، وبذلكَ يعتمدونَ على أنفسهم ويتحكمونَ بها. فهؤلاء الذينَ يرفضونَ أصولَ موضوع المجتمع الديني أو الحكومة الدينية عندما يتمُّ البحثُ في هذا الموضوع نظرياً، ويبقونَ يُشككونَ في كل ِشيء ويقولونَ: إنَّ هذه القوانين ساقطةٌ من درجة الاعتبار. ترى ذاتَ الناس وأثناء الحديث عن المصالح يرونها ذاتَ اعتباراتٍ قطعيةٍ وضروريةٍ وثابتةٍ وغيرُ قابلةٍ للترديد، وعلينا أن نقولَ لهؤلاء السادة في كُلِّ العالم الإسلامي: إننا لسنا متروكينَ لنفعلَ ما نُريد، وليست الأمورُ جميعاً على مذاقنا، فلدينا مؤسَّسةٌ أنثلوجية ثابتة لن تتغيرَ تحتَ أيةِ اتفاقاتٍ أو مصالح.
وعندما يتحدثُ الإمام علي في نهج البلاغة ويصلُ إلى مرحلة الكمال، نرى أنه لا يُريدُ به الإنسان الكامل أو الإنسان الثابت والقياسي، أو الصنم الذي لا يتحرَّك، أو الإنسان الغيرَ طبيعي. بل إنهُ لا ينشدُ إنساناً غيرَ إنساني، إنهُ يتحدثُ عن إنسان طبيعي يتحولُ بإرادتهِ إلى إنسانٍ يفوقُ الحالة الطبيعية. فكلُّ البشر في منطق الإمام إنسانيونَ بالصورة. أي أنَّ هيئتنا تُشبهُ هيئة البشر لكن ينبغي أن تكونَ سيرتُنا كذلك، ولسنا بالضرورة إنسانيونَ بالتعامل. علينا أن نكونَ كذلك، ولذلكَ كانت فلسفةُ الرسول صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلّم حيثُ يقول: (إنما بُعثتُ لِأُتمّمَ مكارمَ الأخلاق). ولذلكَ كانَ الإمامُ علي بالدرجة الأولى مُعلمَ أخلاقٍ، وإمامَ فضيلةٍ حَمَلَ السيفَ بيده وأقامَ حكومةً، وحَمَلَ الصوتَ بيديه، وتَجوَّلَ في الأزقة من أجل تطبيق العدالة.
إنَّ الإسلام بلا جهادٍ وبلا عدالةٍ إسلامٌ شكلي، وهوَ إسلامُ المُرفَّهينَ الذينَ يتأقلمونَ على الدوامِ مع الزمان الحاضر والأجواء العالمية الغالبة. ويسعونَ إلى إيجادِ إسلامٍ يتَّبِعُ المعايير الحاكمة في العالم. وكُلما كانَ الإسلام لا يتوافق مع الخطاب الحاكم على الغرب والعالم، فإنَّ عليهِ أن يُقْلِّمَ أظافرهُ. وينبغي أن يُغيّرَ مساره، لا ينبغي القول ُبالاجتهاد، والإسلام في نظرهم توحيدي، ولكن إن أصبحَ إسلاماً ذا نهجٍ سياسي واقتصاديٍّ وحُقوقيٍّ في المجتمع وأرادَ التغيير فهذا إسلامٌ يُعارِضُ الغربَ الذي يرجو منّا أن نُغيّرهُ ونُعدلهُ. يُريدونَ منا إسلاماً ينفكُّ فيه التوحيد عن كُلِ أصول الحياة، توحيدٌ ذهنيٌّ يتمُّ تبادلهُ في الأذهان والألسُنْ على ألا يكونَ له أدنى تأثيرٍ في العالم الخارجي، أو ألا يكونَ له أدنى ارتباطٍ بمصالح الشركات الرأسمالية. أتصورُ أنكم سمعتم بقصةِ (إكلستون) الذي سَمعَ يوماً صوتَ الأذان أو القرآن، فقال ما هذا الصوت؟ قيلَ له إنهُ الأذان يُرفعُ بينَ فترةٍ وأخرى، يدعو الناسَ إلى الصلاة. فقالَ: وهل في هذا خطرٌ على مصالحنا؟ فقالوا له: كلا، فقالَ: فليفعلوا حتى تتصدَّعَ حناجرهُم.
المدرسة الإسلامية
إنَّ الإسلام الذي يتمُّ انتاجهُ في العالم الغربي يكونُ على هذه الشاكلة، لا يُمكننا قَبولُ الإسلام دونَ أن يكونَ منهاجنا في العمل، أو آلا يكونَ لهُ نظامٌ حُقوقيٌّ يحكمُ به. أو لا يتمُّ الحديثُ عن مُستلزمات تطبيق العدالة، ولا يُمكنُ أن نطلُبَ الإسلام دونَ حقوق الإنسان. لا ينبغي استنباطُ الإسلام عبرَ مصالح الماتريالية ومن ثمَّ طرحهُ مُعلباً وفرضهُ على المجتمع الديني، هذا عينُ الغش. علينا أن نتمرَّنَ على آلا يكونَ اقتصادنا مُغايراً للعرفان، والحقوقُ مُغايرةً للتكليف، والدينُ للحياة. وعلينا أن نفهمَ حقوقَ الإنسان والحكومة والدولة والقانون والاقتصاد والفضيلة من نصوص الدين، وينبغي تفسيرُ الحياةِ والقانون والمدنية في نصوص معرفة الله وعبادته. لا ينبغي تجزئةُ الوحدة الكُلّية لتعاليم الإسلام إلى أجزاءٍ غيرِ مُتناسقة، والخروجُ بكلِّ غيرِ معقول. وعندما يتمُّ تفسيرُ الإسلام جُزءاً بجزءٍ ترى أنهُ صحيحٌ ولا لبسَ فيه، ولكن عندما نجمعُ الإسلام كوحدةٍ واحدة على الطريقةِ التي يبتدعُها هؤلاء دونَ رؤيةٍ للوحدة التي ينشُدها والأهداف الكُلية، ترى الشكلَ الظاهريَّ للإسلام يبدو مُضحكاً. فهؤلاء قاموا في الحقيقة برسمِ كاريكاتورٍ عن الإسلام، لا يختلفُ عن الإسلام الحقيقي في أجزائه، بل في أبعاده. لأنَّ الكاريكاتور يقومُ برسم صورةٍ واقعيةٍ للأفراد لكنَّ أبعادها تكون مُتفاوتة عن الحقيقة ومُضحكة في نفس الوقت. لأنَّ الرسامَ تعمَّدَ عدمَ مُراعاة الأبعاد والتناسب. وهكذا هوَ حالهم أي لا يعرفونَ كيفَ يضعونَ تناسُباً حقيقياً للأجزاء في رسم صورة الإسلام.
هكذا يرسمون صورة الإسلام في الأكاديميات النظرية في العالم. إنهم يفعلونَ ذلكَ لترميم الصدمات التي تحملوها جراءَ زلزال الثورة الإسلامية قبل ثلاثة عقود. والإسلام مدرسةٌ وينبغي النظرُ إليها ودراستُها كمدرسةٍ مُتكاملةٍ من مفاهيمَ معنوية وأخلاقية وكلامية، ولا ينبغي تعريفُ الإسلام بصورةٍ مُطلَقةٍ وفي فضاءٍ عام، بل ينبغي أن يكونَ مؤثراً في الواقع ويتركُ بصماته وأن يكونَ طبقاً لما يصفهُ كبار شخصياتُ الإسلام، أنه ينبغي بيانُ حدودِ معاني الإسلام. وعندما نذكر الدين َ والتوحيد فإننا ينبغي أن نرفعَ كافةَ الحدود الوجودية للدين والتوحيد. رُبما علينا أن نوجدَ في هذا العقدِ حركةَ التوابين ليتبينَ موضع الصديق من العدو في منظومةٍ فكريةٍ جديدة، وأن يتمَّ العودة إلى أصل الثورة من جديد. ويتبين أين هو موضوعُ الخندق وأينَ هيَ مواقع بني أمية وأبي ذر في يومنا هذا، لأنَّ الظروفَ الحالية تُساوي بينَ الشهيد والجلاد، وبين المُجاهد والسارق، بينَ الرمَّال والمُهاجر، بينَ عَبَدْة الإله الواحد ومحبي الدُنيا. لقد اختلط الحابلُ بالنابل، ويقف الجميع إلى جوار بعضهم البعض. لقد تحولنا جميعاً إلى مُحترفي الدين والإسلام، فشُغلُنا الشاغل هوَ أن نقولَ نحنُ مُسلمون والإسلام ليسَ ماركةً إنهُ عقيدةٌ وسلوك. ينبغي أن لايُختصر الدين بينَ الذهن واللسان. لقد جاءَ الإسلام لتغييرِ دُنيانا وآخرتِنا، فالقرآنُ والسنَّةُ وإضافةً إلى المعارف والأخلاقيات والروحانيات، إنهُ عِلمُ جبهةٍ اجتماعية. وينبغي تقسيمُ أصحابِ الله وأصحاب الطاغوت والتفريقُ بينهما، ينبغي فعلُ ذلكَ في الجيل الثالث من الثورة.
وعندما ينتشرُ الإسلام في صفوف الأمَّة يبدأُ صِراعٌ عندَ الإنسان المسلم في نفسهِ، بين الحق والباطل، بينَ الربِ والنفس. وصراعٌ في المُجتمع وفي المجال الاقتصادي والحكم والسياسة بينَ مؤيدي العدالة ومُخالفيها. وينبغي إيجادُ هذا التَخَنْدُقْ من جديد، وبِخلافه ستكون الثورة ميتةً. ينبغي توضيحُ الحدود بين مؤيدي ومُعارضي العدالة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لكنه غيرُ واضحٍ حتى الساعة.
الإسلام الصامت هو الإسلام الذي لا يُبالي بالنظام الحقوقي والسياسي، وهذا النوع من الإسلام مرفوض لأنَّ الإسلام صرخةٌ لا مُناجاة، والإسلام ليسَ عقيدةً ذهنية إنهُ رسالةٌ عملية. الإسلام أيُّها الأخوة نظامٌ روحانيٌّ وأخلاقيٌّ وليسَ حالةً فردية. إنهُ نظامٌ اجتماعيٌّ واقتصاديٌّ وسياسي، هذه أمورٌ يبدو أنها في طريقها إلى النسيان، لأننا لم نعمل بها. وعندما يتجاوز الإنسان أصولاً مُسلمةً بها فإنه سينسى وجودها أساساً، وعندما يتمُّ تجاوزُ ذلك نبدأُ بالشك بها، عندها نفقدُ الجرأة حتى في الحديثِ عنها، ورويداً رويداً يخجلُ الإنسان من الحديثِ عن الثورة والأسس التي انطلق من أجلها الشباب وضحَّوا بأنفُسِهم في جبهات الحرب من أجلها. ومردُّ كُلِّ ذلكَ يعودُ إلى عدم تطبيقنا للأصول الإسلامية وطبيعيٌّ ألا نتفوهَ بها، وعندما نتركُ بعضَ الأصولِ في الحياة العملية فإننا ننسى أن نُجريها على ألسنتنا أيضاً أو نتفوهَ بها.
ماهية الإسلام
ويتساءل الإنسان لماذا نتحملُ أوزاراً لا نحصلُ من ورائها على منفعة؟ لقد سمَّ الإمام علي عليه السلام بعضَ الخارجينَ على الدين اسمَ (القاسطين)، لأنهم خالفوا القِسطَ والعدل وأرادَ الإمامُ من خلال ذلكَ أن يقولَ إنَّ الإسلام ليس ذهنيةً أخلاقيةً وروحانيةً فحسب، بل إنه إضافةً إلى ذلك يعملُ من أجلِ حُكومةٍ ومجتمع خاص. وعلى رأس أهدافه الاجتماعية والحكومية، القيامُ بالقسط، والقسطُ بالإسلام غيرُ مُبهم، فقد تمَّ تعريفه في الإسلام والكتاب والسُنَّة، وليسَ للإسلام قراءاتٌ عدة، والقاسطونَ كانوا من أتباعِ خطٍ فكريٍّ يبلغُ إلى أنَّ العدالةَ وتطبيقَ الأحكام الثورية للإسلام هي خطٌ مُنحرف، وأنَّ هذا الكلام عبارةٌ عن سياسةٍ ليست من الدين في شيء. وأنَّ الدين مُنفصلٌ عن السياسة، وهيَ اقتصادٌ وليست من الدين، إنها من الدنيا ولا ينبغي الحديثُ عنها في المسجد، ولا تتحدثُ عن الجهاد والشهادة وإراقة الدماء. هذه موضوعاتٌ مادية، دعوا هذه الأمور لأهلها من أهل الدنيا، هم يقولونَ للمسلمينَ إن الدنيا عديمةُ القيمة دنيئةٌ فهي لنا، والمقصود أتباعَ النظريةَ العلمانية. الدينُ أمرٌ مُتعالي ومقدسٌ ونورانيٌّ وذاكَ لكم.
لقد أشارت ثورةُ الإمام علينا أنه لا يمكننا العيشُ كيفما اتفق، أو أن نحكمَ كيف نشاء، أو أن نُبرمجَ الأمور مثلما نُريد. ونُسمَّى مُسلمين في ذات الوقت. والإسلام ليسَ ديناً غيرَ مشروط قياساً إلى أنواع النْظُمْ الحقوقية والاقتصادية الرائجة. الدينُ مفهومٌ حيٌّ وديناميكيٌّ وله ملزوماتهُ الحقوقيةُ والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية، لا يمكننا القولُ إنَّ الإسلام سيدخلُ هذا المجتمع دونَ أن يُلقي بظلاله أو لا تُرافقهُ فيه ملزوماته، وبغض النظر عن ملزومات الإسلام، فإن أردنا الحُكمَ عن الإسلام ربما أخطئنا في كُل لحظة أخطاءٌ تتكرَّرُ في عالم اليوم، في المجتمع وفي الصحافة وفي الاعلام وفي الحكم.
إننا نجهلُ تعريفَ وحدودَ وماهيةَ الإسلام، ونقولُ ليسَ مُهماً ذلك فليكن ما يكون. فإذا كانت خُصوصيةُ هذه العملية التي من المُقرر أن تقودنا إلى نتيجةٍ ما، وعلى المجتمع أن يدفعَ الثمنَ لذلك فليسَ مُهماً التحدث عن نوع العملية أساساً، وهناكَ عبارة جميلة لِكهل يقولُ فيها: عندما تكون النتيجة أهمُ من أصل العملية بكثير فلتكن العملية ما تكون لا أب لها. وهذا هو التفكيكُ بينَ الماهية والعملية التي من المقرر أن تُنفذ وتكونُ النتيجةُ حصيلة العملية.
الإسلام والإنسان
إنَّ هذا التفكيك يتمُّ اليوم إعادةُ قولبتهِ في الصحافة ووسائل إعلامنا والمحافل الأكاديمية والثقافية، فإذا كُنا والماركسيونَ نختلفُ في الأساليب الفكرية ونُطلقُ معاً شعار العدالة، فهل سنستطيع ُفي النهاية التوافق وإياهم على أساليب تحصيل العدالة؟ فإن كُنا والليبراليونَ نختلفُ في المباني الإنسانية من الأساس كيفَ يُمكننا التوافقُ على قائمة حقوق الإنسان؟ وكيفَ لنا أن نتفقَ على تعاريف الحرية والجمهورية؟ حتى إنَّ بعض كبار الليبراليين الغربيين قال: إنَّ هذه المُشاركات هي كميةٌ غيرُ نوعيةٍ على مرّ التاريخ، وكيفَ لنا أن نتوافق مع هؤلاء على قضايا مهمة ومصيرية؟ إننا والماركسيونَ والليبراليون نتحدثُ عن إنسانين من عدالتين ونوعين من الحرية، ومن الخطأ أن نتجاوز المُحكمات من أجل المُتشابهات.
وللأسف ومنذُ الثورة الدستورية في إيران وإلى يومنا هذا فإنَّ المُفكرينَ الاجتماعيينَ الإيرانيينَ كانوا مبهوتينَ للترجمات الآتية من الفكر الغربي، وقد حاولوا من خلال المسرحيات والإشارات، القول للمسلمين: إنَّ عليكم إبدالَ الدين إن لم تُلقوهُ جانباً في أقل التقادير.
وللأسف فإنَّ شعبنا كان وخلال فترة الاستبداد الطويلة يُحسنُ قراءةَ الشِفاه، وكانوا يتلقونَ الإشارات من بعيد، لكنهم لم يكونوا عجولينَ في الاستجابة، وكانت ردودُ أفعالهم على ذلك تظهرُ بينَ عقدٍ وآخر وبينَ قرنٍ وآخر.
وخلال القرن الأخير حيثُ تلقى الشعبُ الإيراني فضلات الفلسفة (الأنجلو ساكسونية) العالمية وهيَ في الأساس عالمٌ ضدَّ الفلسفة، عالمٌ من التجربة حيثُ أوردت معها القشريةَ والجزمَ إلى أفكار العالم الإسلامي في إيران. ونظلُّ إلى يومنا هذا نُعاني من تبعات ذلك، وقد أوجدَ ذلكَ ورطةً ميتافيزيقية، حيثُ سدَّ هذا الفكرُ طريقةَ الاعتقاد والإيمان بالأصول والأخلاق والعدالة والحقوق الإلهية في الاجتماع.
فهؤلاء يقولونَ إنَّ مُصطلح الفردية كانَ غريباً بالنسبةِ لأجدادهم، وعليه فقد تمَّ استحداثُ مُصطلح الفرد. وقد قمنا بإبداعِ ذلك استجابةً لحاجاتنا، ماذا يعني ذلك؟ إنهم اكتشفوا الإنسان للتو، وتتمُّ رويداً رويداً مُساعدتهُ. لم تقوموا باكتشافه، لقد فعلَ ذلكَ علي بن أبي طالب عندما قال له: (وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً). ويؤكد عليه السلام فلتعلم أيُّها الإنسان أنكَ بإزاءِ جوار الله. لقد كشفَ عليٌّ عليه السلام الإنسان، وأُريدُ أن أؤكدَ للأخوة والأخوات الكرام لو أننا لا نقومُ بتعريفِ أنفسنا على ما ذهبَ إليه الإمام عليٌّ فإنَّ الفريقَ الآخر سيُقدمُ على تعريفنا، وكما هم يفعلونَ الآن ووفقاً لرؤاهم وسَنُجْبِرُ رويداً رويداً أو نشعرُ بذلكَ بأنَّ علينا أن نسيرَ وفقَ التعريف الذي وصفونا وصنفونا به، حيثُ يقولونَ إنَّ الإنسان ليسَ كما هوَ بل هو مثلما يراه الآخرون وما يقوله الآخرون.
هناكَ سببٌ آخر يرجعُ إلى تعدد وجوهنا، حيثُ نبدو في كلِ جمعٍ بما هم عليه، ونحاول تقمُصَ الشخصية التي يجبُ أن يرانا بها ذلكَ الجمع خَشيةً من الإنسان ألا تتغيرَ زاويةُ وأفقُ نظرة الآخرينَ إلينا. ويبدو أن هذا البلاءَ آتٍ على كلِّ الهوية الاجتماعية في العقد الثالث من الثورة. ثقافةٌ باتت ترى أن حقَّ الله يتعارضُ وحقَ الإنسان، وهي تسعى لحذف الشريعة الإلهية وصولاً إلى الحقوق الإنسانية. وهم لم يَعرفوا البشرَ قبلَ معرفة الله، نتساءلُ لماذا تكون العدالة وحقوق الإنسان مُقدسةً إلى هذا الحد في منطق علي بن أبي طالب وتعتبر ذلكَ أمراً دينياً وفي حُكم الحدود الإلهيَّة؟ ذلكَ أنَّ الحدودَ الإلهيَّة أصلاً جاءت لحفظ الحقوق المادية والمعنوية للإنسان ولهؤلاء الناس وهذا البشر. وإذا لم يكن الإنسان موجوداً فإنَّ الدينَ لم يكن موجوداً هو الآخر، أي إنَّ الدينَ لم يكن لازماً على الاطلاق. إنَّ تطبيقَ العدالة وتأمينَ الحقوق للناس هوَ تكليفٌ إلَهي، وليسَ مسؤوليةً مدنيةً وحَسب. فلا الناسُ عبيدُ الحاكم ولا الحكام عبيدٌ للناس بل الكل عبيدُ الله، ويؤكدُ الإمامُ عليٌّ في عهدهِ إلى مالك الأشتر: أنا وأنتم عبيدٌ مملوكونَ لرب العالمين حيث يقول: (فإنّك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاّك). وإننا بهذه الطريقة مدينونَ لله عز وجل. ولذلكَ بما أنني مدينٌ لله فأنا أخدمكم. أي إنَّ الإمام لا يُريدُ أن يُجاملهم وهوَ يقول: إنهُ لا يعبدُ الناس بل يعبدُ الله عزَّ وجل. لأنَّ الله طلبَ إجراءَ العدالة، لقد قال إنني لستُ عبداً لكم وأنتم لستم عبيداً لي أنا وأنتم عبيدٌ مملوكونَ لربِّ العالمين. وكلما كان هناكَ حقٌّ فهناكَ تكليفٌ أيضاً، وفي منطق الإمام لا ينبغي أن نخشى الحاكمين ولا الناس، ولا ينبغي التّملّقُ للحكام ولا ينبغي التملّق للناس. علينا الخوفُ من الله وحَسب. ويُعَدُّ الرسول أعلى مرتبةَ الآدميين في الإسلام، إنهُ لم يكن بحاجة إلى الناس وتملقهم حيثُ كانَ يُرددُ صلى الله عليه وآله وسلم: إننا فُقراء إلى الله، ولم يكن الرسول ليحسبَ للناسِ حِساباً بصورةٍ مُستقلة، ولم يكن يرآى للناسِ مثلما لم يكن يفعل ذلك مع الله، لأنَّ الله كان يقولُ هؤلاء عبيدي محترمون وينبغي أن تُحفظَ حقوقهم. وكانَ الرسول يخدم الناس بكلِ جوارحه، وتُشيرُ الآيةُ الكريمة المئة والثامنة والعشرون من سورة التوبة، حيثُ يصفُ الله سُبحانه رسولهُ وصفاً جميلاً يُجسدُّ الشخصية الواقعيةَ للرسول، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ)[1] .صدقَ الله العلي العظيم.
وتُشيرُ هذه الآية إلى أنَّ الرسولَ الكريم يتألمُ لِآلامكم، ويهتمُّ لِأموركم، نعم، يتألمُ لِآلامكم ويهتمُّ لأموركم. وفي آيةٍ أخرى من سورة التوبة يقولُ الله عز وجل: (قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ)[2]. أي أنَّ الرسول هو مع الأمة يتألمُ لِآلامها وهو رحيمٌ بالناس. ويقولُ الأستاذ الشهيد (مُرتضى المُطهَّري) الذي ماتزال بعضُ جوانب شخصيته ِغيرَ معروفة: إنَّ البعضَ جاءَ للإمام عليٍّ بعدَ تصديهِ للخلافة وقالوا له: فلتحكم أولاً ولا تستعجل في أمر الثروة التي جناها البعضُ زوراً من بيت المال وأصحابُ القُدرة والثروة، لا تصطدم بهؤلاء ولو أردتَ أن تُقاضيهم في فسادهم المالي والسياسي فإنَّ هؤلاء سيطرحونكَ أرضاً.
شروط الحاكم في المجتمع الديني
لقد صبرت العدالةُ ردحاً من الزمن، فلتصبر عدةَ سنواتٍ أخرى. لقد صبرت العدالةَ قُروناً، وأنَّ تطبيقَ العدالة لا يتأخر، لكنَّ جوابَ أمير المؤمنين لِأصحابه كانَ كالتالي: لِم َتصبر العدالة؟ أستطيعُ شخصياً أن أصبر وأن أُقاوم وأن أُحارب، وقد حصلَ هذا في الجملِ والنهروان وصفين فإمَّا نَقتُل وإمَّا نُقتَل. وقال: لا ينبغي العدالة أن تصبر، إننا نُريدُ الحُكمَ من أجلِ تطبيق العدالة ولا غير، فإن وفِّقنا لذلكَ فبها، وإن لم نوفق نُقتل، وسنمضي بطريق العدالة ولو بلغَ ما بلغ. إنهُ تكليفٌ يتجاوز الزمان، إنهُ ليسَ شيئاً تاريخياً أو زمانياً. بعدَ حرب الجمل جاءَ أحدهم إلى الإمام وقال: كانَ لي أخٌ أحبَّ أن يُشاركَ في الحرب معنا، وأن يَحضُرَ العمليات، فرد عليه الإمام أهوَ أخيكَ معنا. فقد شَهد معنا، ثُمَّ يقولُ عبارةً ألطفَ من هذه: أنَّ أفراداً قاتلوا إلى جانبنا اليوم لم يولدوا بعد، وهم في أصلابِ آباءهم وأرحامِ أُمهاتهم، أشخاصٌ سيولَدونَ بعدَ عقودٍ وقرون وقد شاركونا الأجرَ والثواب.
إنهُ تكليفٌ يتجاوزُ حدَّ الزمان ولن يختصَ بفترةِ الإمام علي، فقد فُتح البابُ في زمنهِ عليه السلام وقد تجاوزوا خُطوطَ القتالِ أولاً، وقالَ الإمامُ علي عليه السلام: كيفَ نُرضي أنفسنا أننا حاكمون، لا أُشارككم في مكاره الدهر. أي إنَّ الحاكم الإسلامي لا ينبغي أن يكونَ بعيداً عن الناسِ وآلامهم، وهذه في حقيقة الأمر رسالةُ عليّ إلى كافة المسؤولين في الحكومة الدينية في كافة العصور، ومعنى هذا أنَّ الإمام دعا المسؤولينَ من الطراز الأول والثاني في الحكومة الإسلامية كالوزراء والنُّواب والمُحافظين والقُضاة، ألا تكونَ حياتهم فوقَ الحد المتوسط للناس، وهذا تكليفٌ دينيٌّ وشرعيٌّ في الحكومة الإسلامية. ودعا عليه السلام المسؤولينَ إلى أن تكونَ حياتهم بمستوى عامة الفُقراء كي يشعروا بضائقة العيش التي تمرُّ على الفُقراء، كي لا يشعُرَ الفقراءُ أنهم وحيدونَ في المكاره ويقولون إنَّ المسؤولينَ قد تناسونا ونحنُ نعيشُ بشكلٍ والآخرونَ يعيشونَ بشكلٍ آخر. لقد أكَّدَ الإمامُ على ضرورةِ إرضاء عامة الناس لا الخواصَ وأصحابَ النفوذِ والثروة ولا قادةَ الأحزاب والجماعات ولا من ينشدُ حقّاً أكثرَ من الآخرين.
ويؤكدُّ الإمامُ في عهده إلى مالك الأشتر حولَ الاهتمام بأمورِ عامة المسلمين وكسبِ رضاهم خاصةً المحرومينَ، ويقول: (ليكن أحبُّ الأمورِ إليكَ أوسطُها في الحق، وأعمُّها في العدل، وأجمعُها لرضى الرعية). ثُمَّ حذَّرَ عليه السلام من غضب الرعية على أساسِ إرضاء أصحاب النفوذ والقدرة وقال: إن سَخَطَ الخاصة يُغتفر مع رضى العامّة. ويؤكدُّ على ضرورة التعاملِ مع الرعية التي تُعدُّ هي الدعامة الأساسية للسلطة والسواد الأعظم من المُشاركينَ في الجهاد، ويؤكدُّ أننا لو قلبّنا جيشَ المُسلمين لن نجدَ فيهم مُتمولاً واحداً يُشاركُ في الجهاد، وإن كانَ فقد انسلخَ من طبقته. ويؤكدُّ الإمام: (كذلك فليكن ميلُكَ معهم)، ويُشيرُ أنَّ على المسؤولينَ أن يُفكروا في حل مشاكل الناس ولا ينبغي لهم أن يُزيدوا منها حيثُ يقول عليه السلام: (أطلِق على الناسِ عُقدةَ كُلِ حقد)، أي إذا كانَ هُناكَ سوءُ تفاهم فاعمل على حله، وإن لم تستطع فتحدث مع الناس، ويقولُ عليه السلام: إن ظنت الرعيةُ بكَ حيفاً وبدأ الناسُ يتحدثونَ من وراءكَ ويقولونَ إنَّ مالكاً باتَ كالآخرين وإنهُ كذا وكذا، فعليكَ أن توضح لهم الأمور، حيثُ يقولُ عليه السلام: (أصحر لهم بِعُذرك).
وهكذا ينبغي أن يكونَ الحاكمُ في الحكومة الدينية لا يدعُ مجالاً للشائعات، وعليه أن يُصارحَ الرعية، فإن أخطأ الحاكمُ عليه الاعتذارُ إلى الرعية، وإن كانَ معذوراً فعليهِ مُصارحةُ الناس. وترى السادة من أصحاب المدرسة العلمانية يقولون: إنَّ الحكومة الدينية أو الحكومة السماوية أو الحكومة القدسية ليسَ فيها نقدٌ ولا إشرافٌ ولا سؤالٌ أو إجابة لتساؤلات الرأي العام، إنها حكومةُ استبدادٍ ديني. ليسَ هذا الكلامُ مطروحاً بعدَ الثورة الدستورية في إيران، ولا من تأثيرات النصوص المترجمة للديمُقراطية، إنهُ عينُ الحقيقة ونصُّ الدين، ويعودُ إلى أكثرَ من ألف عامٍ ونيّف. علينا أيُّها الأخوة أن نوضِّحَ ذلكَ للرأي العام، لا تجعلوا الناسَ يظنونَ بكم سوءاً، وتُضافُ عُقدٌ إلى العُقد الموجودة، وتُضافُ مشاكلٌ إلى المشاكل الموجودة.
ومن توصيات الإمام عليه السلام: أنَّ على الحاكم أن يُغطّي سوءات الناس، ولا يُفتّش عن عيوبهم، هذه خصائص الحاكم الإسلامي. لقد حذَّرَ الإمامُ من الاستفادة من أصحاب القلوب المريضة الذينَ يبحثونَ على الدوام في عيوب الآخرين في المناصب الحكومية و ألا يكونوا من أصحاب الحاكم. ثُمَّ يقولُ أميرُ المؤمنين سلام الله عليه: (إنَّ في الناسِ عيوباً الوالي أحقُّ من سترها). أي يتوجب على الحاكم أن يستُر عيوبَ الناس ويحفظها، حتى إذا أخطأوا وفَسَدوا، إلا إذا أصرَّوا على ذلك أو أنهم تجاوزوا حقوق وحدودَ الله، عندها ينبغي عقابهم. هل نجدُ حكومةً أكثرَ إنسانيةً من هذه الحكومة في العالم؟ هل إنَّ هؤلاء هم الذينَ اكتشفوا الإنسان؟ أم اكتشفهم الإسلام قبلهم بكثير؟ يُشيرُ الإمامُ علي عليه السلام: لو أنَّ الحاكم أُجْبِرَ على عقاب أحدهم لا ينبغي له أن يكونَ فرحاً بعقاب الآخرين. وهذه توصياتٌ إنسانيةٌ كُبرى، لا بل فوقَ الإنسانية.
ويوصي الإمامُ مالكاً، أنه لو أرادَ أن يُعاقبَ أحدهم، عليه أن يفعل ذلك بقلبٍ مِلْؤُهُ الحزن، لا أن يقومَ بذلكَ بنية الانتقام وغير ذلك، وإذا ما أخطأ الإنسان ينبغي عقابه والعقاب هو لصالح الفرد والمجتمع. ورغم ذلك لا ينبغي للحاكم أن يكونَ مسروراً بالعقاب، ليكن حازماً وليُنفذ العقوبة ولا يُقصّر في ذلك، وليُنفذ قانون الله عز وجل حتى وإن قالوا إنَّ القصاصَ عنيف، نفذ القانون ولا تأخذكَ في الله لومةُ لائم. ويدعو الإمام عليه السلام إلى حلِّ قضايا الناس وعدم تعطيلهم في دواوين الحكم، ولا ينبغي إرجاعُ الأمور إلى الموظفين الأدنى، هذا هو تحديد البيروقراطية. وهناكَ بونٌ شاسعٌ في الفرق بين دوائر الماضي واليوم.
إنَّ على الحاكم والمسؤول أن يحلَّ قضايا الناس واستفساراتهم فوراً، ويُضيف: (وأمضي بكلِ يومٍ عملهُ، فإنَّ لكلِ يومٍ ما فيه)، أي لا تُأخر حلَّ قضايا الناس إلى يوم الغد.
لقد نُقلَ الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، أنهُ ذاتَ يومٍ شوهدَ الإمام يتجولُ في أزقة المدينة وهوَ يَشعرُ بالقلق، فسئِلَ ما الخبر يا أميرَ المؤمنين؟ فقالَ: أن هناكَ بقايا من مال ٍفي بيت المال ولم أوزعهُ، هناكَ بعضُ الدنانير وأخشى أن يهبط الليل ولم يصل إلى مُستحقيه، أريدُ التخلُصَ من بقايا المال هذه قبلَ حلولِ أذان المغرب.
وقد نُقلت الرواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً، أنهُ ذاتَ يومٍ أقبلَ عليهِ أعرابيُّ من البادية، فأخذهُ مقام الرسول وشخصيتهُ وخشيَّ الحديثَ في حضرة الرسول، أو أن ينظر إلى وجه وعيني الرسول. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إنني ابنُ أمٍّ كأُمك تحلب الماعز، هيَّا كن طبيعياً وتحدث. وفي روايةٍ أخرى أن الرسولَ كان يمضي مع عددٍ من أصحابه في زقاقٍ ضيق، وإذا بامرأةٍ سليطة اللسان ضخمةُ الهيكل قطعت عليهم الطريق، وعندما وصلوا لم تتزحزح يميناً أو شمالاً وظلت مُتسمرة في مكانها، فقال لها أحدُ الصحابة وَيحَكي تنحي جانباً لِنَمُرْ. فقالت: غيّروا طريقكم واسلكوا زُقاقاً آخر. فثارَ أحدُ الأصحاب وتقدمَ ليُزيحها عن طريق الرسول فقال له: دعوها، إنها جبَّارة. ثمَّ رجع الرسول واختار المرورَ من زُقاقٍ مُجاور. هذه هيَ نظرةُ الإسلام للرعية، ونظرةُ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليّ سلام الله عليه إلى الإنسان. إنهم يحترمونَ حقوقه ُوحُرمتهُ دونَ أن يتملقوا لِأحد دونَ أن يعبدوا أحداً، وكانوا يرونَ أن الإنسان هو مبدأُ كلِّ الحقوق وكلِّ المشروعيات، ومِلاكُ الحقِّ والباطل، وهم في ذات الوقت أدَّوا حقوق وحرمةَ الآخرين منذُ أن وطأة أقدامهم ميدان السياسة والاجتماع حتى لحظةِ رحيلهمِ عن هذه الدنيا. هكذا تكونُ حاكميةُ المجتمع الديني.
[1] – سورة التوبة: الآية: 128.
[2] – سورة التوبة: الآية: 61.
المصدر: رابطة الحوار الديني للوحدة












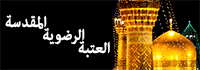

تعليقك