وكالة أنباء الحوزة - أقامَ سماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي صلاةَ عيد الأضحى المبارك بمكتبهِ في النجف الاشرف، وألقى خطبتي صلاة العيد على جموع المؤمنين الذين وفدوا لزيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وقد كانت الخطبة الأولى من قبسات الآيتين المباركتين22-23 من سورة الشورى (تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ*ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ) [الشورى 23-22].
وقد استهلّ سماحتُهُ الخطبة الأولى ببيان دلالات الآيتين المباركتين، مشيراً إلى المقارنة بين المؤمنين وما ينتظرهم من نعيم عظيم وحياة طيبة هانئة سعيدة في أجمل مواقع الجنة جزاءً لعملهم الصالح وطاعتهم لله تبارك وتعالى وبين الظالمين وما ينتظرهم من المصير السيء والعذاب الواقع بهم من أعمالهم السيئة التي ارتكبوها واضاعوا عمرهم فيها.
وأوضح سماحتُهُ ان المقارنة بين المؤمنين والظالمين وبيان مصير كل منهما، يصلح أن يكون دافعاً للإلتزام بالحق وسلوك طريق الصلاح، لافتاً إلى كونه اسلوباً تربوياً مؤثراً من باب (ازجر المسيء بثواب المحسن).
وأشار سماحتُهُ إلى أن ألله سبحانه وتعالى قد أنعم على المؤمنين في الجنة بحصولهم على ما يرغبون ويشتهون من دون الحاجة إلى القيام بمقدمات أو أسباب الوصول لذلك، وما يزيدهم هناءً أنهم (عند ربهم) (ولهم ما يشتهون) [النحل: 57] وليس كما في الدنيا حيث كانوا يمتنعون عن بعض ما يشتهون لأنه محرم عليهم أو يعجزون عنه، موضحاً أن ختام هذه الآية المباركة جاء ليبين أن هذا النعيم لا يُنال إلا بفضل كبير من الله تعالى فهو الهادي إلى الإيمان والعمل الصالح، ولاشك إن هذا النعيم لا يُقاس به نعيم الزائل المنغص بعوارضها واسقامها.
وبيّنَ سماحتُهُ أن الهداية العظيمة التي افاضها الله تعالى على عبادهِ بواسطة رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله) وهذا الأداء للرسالة الإلهية لم يطلب (صلى الله عليه وعلى آله) عليه اجراً؛ لأن عمله خالص لله تبارك وتعالى، وكل ما يريده هو نفعهم وفوزهم وفلاحم وسعادتهم رحمةً بهم ، مشيراً إلى أن هذا مبدأ عبَّر عنه جميع الأنبياء (صلوات الله عليهم أجمعين ) بوضوح وحكاه الله تعالى في سورة الشعراء عن نوح وجهود وصالح ولوط وشعيب فقالوا بلسان واحد (وما أسألكم عليه من أجرٍ إن أجري إلا على ربّ العالمين) [ الشورى 109، 127 ، 145 ، 164 ، 180] ؛ لأنهم عباد مخلصون لله تعالى ، وهكذا كان المعصومون من أهل بيت النبي (صلى ألله عليه واله).
وتطرق سماحتُهُ إلى قوله تعالى (إلا المودة في القربى) ، وأن المودة هي المحبة والميل إلى الشيء، ومن الأسماء الحسنى (الودود) [ البروج 14] ، لافتاً إلى الفرق بين الحب والودّ، كما أشار سماحتُهُ إلى أن المراد بالقربى: مجموعة خاصة من القربى؛ لقوله تعالى (في القربى) الدالة على الظرفية بمعنى أن المودة فيهم وليس لهم جميعا؛ إذ لم يقل: للقربى حتى يمكن إفادتها العموم ، موضحاً أن إختيار لفظ المودة من الآية أن الفطرة النقية والطبع السليم يقتضي محبة أهل البيت (عليهم السلام) والميل إليهم لإجتماع صفات الجمال و الكمال فيهم.

وفي ذات السياق ذكر سماحتُهُ إن النبي الأكرم (صلى ألله عليه وآله) إختصّ من بين الأنبياء بهذا الإستثناء المتصل أو المنقطع، وهو طلب إشتراطه على الأمة المودة في القربى، وهولاء القربى مخصوصون إختارهم الله تعالى لحمل الرسالة ومواصلتها واستمرار هداية الناس إلى الله تبارك وتعالى فهذا الطلب ليس عاطفياً ، بل هو تخطيط إلهي لإستمرار القيادة الربانية بأقرب الناس إلى رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله) سمواً ومكانةً وعملاً ومنهجاً ؛ لحفظ الرسالة و ديمومتها وإتقان أدائها، و قد استفاضت الروايات بل تواترت من طرق الفريقين وهي تدل على أن المراد بالقربى في الآية الكريمة هم أهل البيت (عليهم السلام) ، ولوضوح هذا المعنى وحقانيته فقد نظمه الشافعي في أبيات من الشعر، كما نجده قبل ذلك في شعر الكميت الأسدي، ثم أشار سماحتُهُ إلى جملة من الروايات والشواهد التاريخية التي تثبت حقانية أهل البيت عليهم السلام وفي مقابل ذلك لفت سماحتُهُ إلى محاولات أعداء أهل البيت عليهم السلام من الأمويين و العباسيين وغيرهم ومساعيهم لتضليل الناس وصرفهم عن أهل البيت (عليهم السلام).
وفي ختام خطبته الأولى ألمح سماحتُهُ إلى ان الموالين لأهل البيت (عليهم السلام) قد اُشربوا حب أهل بيت النبوة (صلوات الله عليهم أجمعين)، والإندفاع في مودتهم وطاعتهم والتضحية من أجل ترسيخ وجودهم ونشر مبادئهم، لافتاً إلى أن مما نظهر به مودتنا لأهل البيت (عليهم السلام) إقامة مجالس ذكرهم، وإحياء شعائرهم ومن أهمها زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الغدير الأغر ففي ذلك نصرة لحق أمير المؤمنين (عليه السلام) وخيبة لأعدائه وتثبيت على الصراط المستقيم.
وفي الخطبة الثانية تعرض سماحتُهُ لقبس من الآية المباركة 79 من سورة النساء (ما أصابك من حسنة فمن الله و ما أصابك من سيئة فمن نفسك) ، مبيناً أنّ الآية الكريمة بصدد تصحيح جملة من الاعتقادات والتصورات المشوّهة لدى بعض الناس، وقد كان محل الحديث ما نجده على أرض الواقع وهو أنه إذا أصيب أحد بمصيبة كمرض أوحادث سير أو فقدان عزيز أو خسارة مال، فإنه ينسب الفعل إلى الله تعالى و ربما يعترض على القدر الذي تعرض له، لافتاً إلى فساد هذا الإعتقاد لما فيه من سوء الظنّ بالله تعالى ، كما أنّه ربما يؤدي إلى أنّه لا يحب الله تعالى؛ لأنّه لم يختر له ما يحب، فلابد من تصحيح هذا الإعتقاد؛ لأن الله تعالى لا يصدر منه إلا الخير المحض و هو شفيق بعباده و رحيم بهم، فعلينا أنّ نعمل لتحبيب الله تعالى إلى الناس لنحظى بالمنزلة العظيمة عند الله كما نصت الروايات الشريفة.
وألمح سماحتُهُ - من خلال الآية الكريمة - أن ما يصيب الإنسان من خير فهو من الله تبارك وتعالى؛ لانّه تعالى هو الذي يهديه للإيمان ويوفر له ظروف الإمتثال ثم يتقبل منه ويثيبه بأحسن الجزاء، أما السيئة التي تصيب الإنسان فهي من فعله وتسبيبه، فهو الذي أتبع شهواته ونزواته وهوى نفسه فوقع في المحذور، وهو الذي لم يتصرف بحكمة ولم يعمل بمنطق العقل فأضرته حماقته وهكذا، فلماذا بعد ذلك يأتي هذا الإنسان وينسب كل ذلك إلى الله تعالى؟
وأضاف سماحتُهُ انّ الآية الكريمة وإن كان لسانها توجيه الخطاب إلى النبي الأكرم (صلى ألله عليه واله) إلا إنها في الحقيقة موجهة إلى الناس من خلال النبي الأكرم (صلى ألله عليه واله) على طريقة (إياك أعني واسمعي يا جارة)، موضحاً أنّ المراد بقوله تعالى (من نفسك) قد يكون كل ما سوى الله تعالى الشامل له ولغيره؛ إذ لا شك أن بعض ما يصيب الإنسان هو بسب حماقة الآخرين و جهلهم أو عمدهم و عدوانهم، قال تعالى (و ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير) [الشورى:30] وفي سياق الآية الكريمة وآيات اُخر نسبت الحسنة والسيئة إلى الله تعالى،

أكد سماحتُهُ عدم وجود تنافٍ كما في الآية 78 من سورة النساء؛ إذ انّ هذه الآية الكريمة نزلت للرد على عقيدة فاسدة حيث كانوا ينسبون الخير إلى الله تعالى إذا كثرت الأمطار و أينعت الأرض و ساد الأمن، وإذا حصل شرٌّ ما ، نسبوه إلى رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله) محاولةً منهم للتفريق بين الله تعالى ورسوله الكريم (صلى الله عليه وآله)، والطعن في القيادة الربانية؛ لإيجاد المبرر لعصيانها وعدم تحمل معاناة الطاعة، فجاءت هذه الآية المباركة لتحبط هذه المحاولة الخبيثة، ونسبت السيئة إلى الله تعالى لأنها ما دفعت إلا بإذنه وضمن القوانين التي اُجري الخلق عليها، ولو شاء الله تعالى لدفعها كما عطّل صفة الإحراق لنار إبراهيم (عليه السلام)، فالفعل ُينسب إلى الله تعالى زمن هذه الجهة لكنه لا ينفي المسؤولية عن فاعله، كمن رمى نفسه من شاهق فإنه مسؤول عن إتلاف نفسه، وقد نصت جملة من الآيات المباركة والروايات الشريفة على ذلك.
وفي ختام خطبته الثانية ذكر سماحتُهُ إنّ الإنسان هو السبب المباشر لحصول السيئة منه، لكن على الرغم من ذلك فإن الله تعالى لم يوكله إلى نفسه رحمةً به وشفقة عليه، فتولى رعايته والإحسان إليه من خلال عدة أمور:
منها: إنه تعالى يدفع عنه ويمنع وقوعه وإن أتى الإنسان بأسبابه.
ومنها: إن الله تعالى يعفو عن كثير من سيئات الإنسان ويلغي تأثيراتها السلبية وما يصيبه فهو من القليل المتبقي.
ومنها: إن الله تعالى يثيب العبد على ما يصيبه وإن كان بسببه ويجعل البلاء كفارةً للذنوب، وبذلك يحوِّل الله تعالى البلاء والمصيبة التي جرّها العبد على نفسه إلى نعمةٍ لصالحه، حتى أن الروايات دلّت على أن المؤمن لما يرى ما أعدَّ الله تعالى له من الثواب العظيم يتمنى أنه لم يرفع عنه بلاء.
ومنها: إنه سبحانه يجعل البلاء سبباً لتكامل الفرد وقربه من الله تعالى.
وقد استشهد سماحتُهُ على كل أمر منها بجملة من الآيات المباركة والروايات الشريفة.














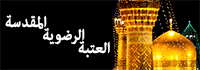

تعليقك